مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
| الحسين ابوهوش | ||||
| الضباشي | ||||
| الحسن سلمي | ||||
| أبو يحيى | ||||
| said26p | ||||
| amjdtaza | ||||
| abou aimrane0834 | ||||
| oumalaeddine | ||||
| sociologue | ||||
| aqdazsne |
منع النسخ
الإطار السوسيولوجي للمعرفة الإستشراقية
صفحة 1 من اصل 1
 الإطار السوسيولوجي للمعرفة الإستشراقية
الإطار السوسيولوجي للمعرفة الإستشراقية
الإستشراق، الإنتروبولوجيا، السوسيولوجيا: مدخل إلى سوسيولوجيا الإستشراق
ما زال هناك تقصير على المستوى السوسيولوجي في دراسة الإستشراق، فبإستثناء عمل إدوارد سعيد[1] وهشام جعيط وأنور عبد الملك[2]، فإن الدراسات المتعمقة في تحليل تطور البنى المعرفية الإستشراقية وربطها بالبناء الإقتصادي والإجتماعي وبالتطور التاريخي تكاد تكون معدومة. من هذا المنطلق فإن هذه الورقة هي مجرّد محاولة أولية لتحليل الأطر الإجتماعية للمؤسسة المعرفية الإستشراقية عبر تطورها التاريخي مع قراءة لأبرز طروحات هذه المؤسسة ومقارباتها للموضوع.
- الإطار السوسيولوجي للمعرفة الإستشراقية:
لعبت الحركة الصليبية في عصر الإقطاع دوراً تأسيسياً في رسم معالم العلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فقد جسّد المشروع الصليبي النواة الصلبة لحركة عدائية عملت على تأسيس الشرخ العميق والهوّة التي فصلت بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق يدخل الزمن الصليبي في صلب العلاقة التاريخية المتوترة والعدائية التي وضعت الإسلام دائماً في حالة دفاع متواصل ضد الغرب الذي أفزعته إنتصارات وفتوحات الإسلام. إلاّ أن الأهداف الحقيقية للمشروع الصليبي لم تكن مجرّد إستجابة لضرورات دينية، وإنما كانت في جوهرها تحقيق لأهداف وأطماع تجارية وإقتصادية في الشرق من جهة، وتجسيد مادي وتاريخي (فوبيا phobia) أوروبية إيديولوجية من هذه القوّة المتصاعدة من جهة أخرى فقد " شكّل المسلمون بالنسبة للغرب المسيحي لفترات طويلة، خطراً قبل أن يصبحوا معضلة"[3].
من هنا يصبح من الضروري وضع الدافع الديني في إطار هذه الدوافع الرئيسية التي تحكمت إلى حدّ بعيد بمسار الأحداث ونتائجها والتي يميل البعض إلى تجاوزها والتقليل من شأنها.[4]
والواقع أن الدافع الديني لم يكن سوى ذريعة لتغطية الدوافع التجارية والإقتصادية والسياسية الكامنة في المشروع الصليبي، وهذا ما يؤكده العديد من الباحثين والأكاديميين والمؤرخين العرب والأجانب الذين أرّخوا للمرحلة الصليبية.[5]
ترافق هذا الأمر مع نوع من الإضطهاد والفقر شهد أوروبا عانى منه الفلاحون والأقنان أكثر طبقات المجتمع الإقطاعي حرماناً بسبب إستبداد رجال الإقطاع وتسلطهم، ومما زاد الأحوال الإقتصادية تردياً سوء المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والمجاعة وإنتشار الأوبئة والأمراض، الأمر الذي أرهق كاهل هذه الطبقات وزاد من بؤسها. بالإضافة إلى ذلك فقد كان لفوضى الصراع الإجتماعي بسبب الحروب الداخلية المتواصلة بين الأمراء الإقطاعيين الدور الفعال وتفاقم هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة. لقد دفعت هذه الأزمة التي سبقت المشروع الصليبي مباشرة الكثير من أبناء هذه الطبقات إلى المشاركة في هذا المشروع أملاً بالخلاص من ظروفها المعيشية السيئة.[6] لقد هيأت هذه الظروف جميعها مناخاً مناسباً للسلطة الدينية لإستغلاله في تحقيق مشروعها الصليبي، الذي تحوّل إلى سياسة خارجية شبه وحيدة للبابوية. هذه الخلفية التاريخية تمثّل الإطار الإقتصادي والإجتماعي وبدونها لا يمكن تناول المعرفة المتعلقة بالشرق من حيث المحتوى والشكل والسياق، سوسيولوجيا المعرفة، سواء مع كارل مانهايم أو ماكس شيلر، أو ماركس فيبر لا تكتفي بتحديد البعد السوسيوتاريخي للمعرفة بل لا بد من ربطها بالوظيفة الإجتماعية وبالأطر الإجتماعية الإقتصادية التي إنبثقت عنها والدور الذي يقوم به هذا المحتوى أو الناتج المعرفي في خدمة النظام الإجتماعي والسلطة الحاكمة فيه.
ولما كانت المؤسسة الكنسية أقوى المؤسسات نفوذاً أو سلطة في عصر الإقطاع، فمن الطبيعي أن يكون محتوى المعرفة المتعلقة بالشرق أثناء الحروب الصليبية وفي أعقابها محتوى دينياً منسّقاً في مجمله مع الأوضاع الإجتماعية التي سادت مرحلة الإقطاع من جهة، والرامية إلى خدمة هذه المؤسسة الدينية/ الكنيسة من جهة أخرى. ففي هذه الفترة التاريخية من تطور المجتمع الغربي شكّل الدين نظاماً إجتماعياً متكاملاً تداخلت في تكوينه عناصر إجتماعية وإقتصادية وتاريخية أهّلته للقيام بوظيفة الدفاع العام لتحقيق التضامن الجماعي بين أفراد المجتمع ضد الإسلام.
إنطلاقاً من هذه الخلفية لجأت السلطة الدينية الكنسية لتصوير الدين الإسلامي على أنه "التهديد " أو " الخطر" الذي يهدد الجماعة بوجودها ووحدتها، لذا شنّت بوصفها أقوى مؤسسة معرفية حملة معرفية تحضيرية منظّمة ضد الإسلام والمسلمين مصورة الإسلام على أنه دين "رجعي" و "قمعي" و "باطل" أوجده رجل " مشعوذ" و "دجال كبير"، أما المسلمون أنفسهم فهم متوحشون "كفار" و "مهرطقون" وهكذا نجحت الكنيسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في تعميم معرفة هذا ثقافة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. وعلى الرغم من أن العديد من الرحالة والتجار الأوروبيين قد جذبهم الشرق بغناه وثروته، فتزايد عدد من تقدّم منهم بحثاً عن المغامرات أو الصفقات والمال، بل تزايدت أيضاً جنباً إلى جنب حملات التبشير والمبشرين، وسجلت العديد من الكتابات في هذا المجال، إلاّ أن هؤلاء التجار والرحالة ما جاؤوا إلى الشرق إلاّ ومعهم أفكارهم المسبقة وصورهم الجاهزة Pre-stereotypical images عن الشرق فلم يعطوا لأنفسهم الفرصة الكافية للتعرّف على هؤلاء "الآخرين" ولم يحاولوا فهم البيّنة السياسية والإجتماعية للمجتمع العربي، ولم يقيموا أي حزب من التفاعل المباشر بينهم وبين هؤلاء الآخرين من شأنه أن يعدل من حدّة هذه الإتجاهات المسبقة النمطية الجامدة. وهكذا فإن العديد من الصور النمطية عن الشرق كانت قد خلقت ذاتياً Self-created إلى حدّ كبير بهدف ملاءمتها للحاجات الإقتصادية والسياسية لهؤلاء الرحالة والتجار.[7] لقد تحول المسلم على يد هؤلاء إلى "غني" و "قرصان" و "تاجر رقيق" فضلاً عن كونه "مهرطق ومتوحش وهمجي" كما في الصور السابقة. كان هناك جمهور كبير يتلقف ما يكتب عن الشرق. والواقع أن الدراسات الإستشراقية إنطلقت من هذه البيئة ومن هذا الإطار، ونحن لهذا السبب يجب أن ندرك الإرتباط بينها وبين التبشير. فقد صادق مجمع فيينا (1312 م) الكنسي على أفكار روجر بيكون (1214- 1294م) وريمون لول ( 1225- 1216م) واللذين كانا يعتقدان بضرورة دراسة الحجج المضادة حتى يمكن دحضها، وأنه بالتالي حان الوقت لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير كي تزول العقبة الكبيرة التي تقف في سيبل تحوّل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثوليكية. وقد صادق مجمّع فيينا على هذه الأفكار وأقرّ تعلّم اللغات الإسلامية والعربية تحديداً إلى خمس جامعات أوروبية (باريس- أكسفورد- بولونيا- سلمنكا- جامعة المدينة البابوية).
ومما هو جدير بالذكر أن قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج عام 1626 نصّ صراحة على خدمة هدفين أحدهما تجاري والآخر تبشيري كهنوتي بهدف توسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية "بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات" كما جاء في خطاب للمراجع الأكاديمية المسؤولة في جامعة كمبردج إلى مؤسس هذا الكرسي.
- الإستشراق والإستعمار:
شهدت هذه المرحلة من تطور المجتمع الغربي تغيّراً واضحاً في محتوى وشكل المعرفة المتعلّقة بالشرق، فما حدث في أوروبا من تغيير في البنى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية مع الثورة الصناعية أدّى إلى توليد معرفة جديدة ذات مضمون إستعلائي وعدائي، عمد إلى تثبيت الصورة السلبية السابقة عن العرب والإسلام وأضاف نوعاً من الشرعية الأخلاقية عن الإدعاء بالتفوّق الحضاري والدور الملقى على الغرب بسبب تفوّقه الحضاري للأخذ بيد هؤلاء المتخلّفين، فظهرت مقولات "نحن" و"هم" و "غرب" و "شرق"، وهو ما عبرت عنه التقانة الإنكلوساكسونية عبر العبارة المشهورة عبء الرجل الأبيض (With man's burben) والتي تعبّر عن التمركز حول الذات والتي تفضي إلى أن تعتبر مجموعة بشرية ما، نفسها مرجعية لسائر المجموهات البشرية، وهذا يخفي شعوراً بالتفوق يتخّذ في غالبية الأحيان شكل الغطرسة وإزدراء الآخر، وبالتالي يصبح التاريخ "الذاتي" إطاراً لفهم العالم والحكم عليه، مما ينتج سلوكاً ينطلق من معيار أن ما يصلح للذات لا بد حتماً يصلح للآخر ولا بد من تعميمه.
عيوب نزعة "التمركز حول الذات" أو ما يسمّى في العلوم الإجتماعية الإثنية المركزية Ethnocentrism وهي النزعة التي تماهي بين الغرب والعالم وتعتبره عالم إمتداداً للغرب، بحيث تصبح السياسة الغربية تجاه الآخر مجرّد سياسة محلّية، تعبّر عنها أيضاً العبارة الإنكليزية الرائجة The west and the rest أي الغرب والباقي، وهذا ما تمّ ترجمته عملياً في سلوك إستعماري مارسه الغرب في مختلف قارات العالم إقترن بممارسات يندى لها جبين البشرية من النهب والقتل والتهجير.
عندما أرادت السلطة السياسية للدول الإستعمارية الكولونيالية التوسّع خارج حدودها الجغرافية بحثاً عن الأسواق والمستعمرات، إستعانت بالتراث الإستشراقي من أجل تسهيل عمليات التوسع، وقد قدم الإنتروبولوجيون خدمات جلّى في هذا المجال، ووضعوا خلاصة أبحاثهم ومعرفتهم المتعلّقة بكيفية التعامل مع هذا الآخر.
لقد استطاعت الإدارات الإستعمارية توظيف طاقات المستشرقين والإعتماد على جهودهم لخدمة أغراضها في ترسيخ سلطتها في المستعمرات، وأصبح العمل لدى هذه الإدارات وسيلة إرتزاقية لدى العديد من هؤلاء،حتى أنه من النادر أن نجد إسماً حتى من بين كبار المستشرقين بقي بعيداً عن لعبة تقديم الخدمات لحكومة بلاده في غدارة مستعمراتها.
لقد شكّلت معرفة المستشرق بالشرقي نوعاً من السلطة جعلته يدعي أنه خبيراً بخصائص وطبيعة الشرق وفئاته الإجتماعية فها هو Burton يدّعي بحكم خلفيته الإنتروبولوجية معرفة سمات شخصية البدوي وتركيبه النفسي والمزاجي حيث يقول :"إن بسالة البدوي نزقة وغير مؤكدة. والإنسان هو بالطبيعة حيوان مفترس، تكبحه علاقات المجتمع المعقّدة، ولكن سرعان ما ينحدر إلى عاداته القديمة. وخصال الضراوة والتعطّش للدماء تنمو سريعاً في الصحراء. إن الهمج وأشباه البرابرة هم دائماً حذرون ومحتاطون، أما المتحضّر فهو على نقيض ذلك. إن معاني الشجاعة عند العرب لا تخلب ألبابنا[8]". إن هذه المعرفة التي يمتلكها المستشرق عن الشرقي جعلته لا يقف عند هذا الحدّ من الإدعاء، بل أعطته سلطة خوّلته الذهاب إلى أبعد من ذلك، إلى حدّ الزعم بأنه "الوحيد" القادر على فهم نفسية و "عقلية" الآخر/الشرق، أكثر من معرفة الشرقي لها[9].
والواقع أن الإستشراق أصبح في حقيقة الأمر جزءاً من قضية الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، وكان له الأثر الهام في صياغة التصورات الأوروبية عن الإسلام وفي تشكيل مواقفه منه ومن قضاياه على مدى قرون عديدة. بل إن الغرب لم يكتفِ بفهم دراسة الإسلام وحضارته كما يريد عبر الإستشراق، بل أراد أن يفرض هذا الفهم على المسلمين، وكأنه بإختصار يريد إعادة تشكيل عقلهم، وإعادة تركيب عقل آخر قام هو بإختراعه في رؤوسهم، يحمل ما يراه مناسباً، لأنهم لا يعرفون مصالحهم الحقيقية التي يعرفها الغربيون المستشرقون نيابة عنهم بطريقة أفضل. لذلك نصب المستشرقون من أنفسهم أوصياء بلسان الغرب على الشرق والشرقيين.
- الإستشراق والإنتروبولوجيا:
وجد الإنتربولوجيون مادتهم الأولى عند الشرق وعند الإسلام فيما كتبه المستشرقون والرحالة، فكانت تلك هي البدايات، لذلك يربط إدوارد سعيد بين الإستشراق والإنتروبولوجيا ليس في النشأة فقط، بل في المادة التي إعتمداها، ثم في أنهما علمان إستعماريان، أو أنهما نشآ في مرحلة الإستعمار ولخدمته. وهذا صحيح وإن كانت الإنتروبولوجيا كعلم وضعي متطور نشأ في القرن التاسع عشر، بدأ بجمع المعلومات ووضع الملاحظات في القرنين السابع عشر والثامن عشر عمل على تعميمها وتصنيفها، وهو فعلاً خضع لتوظيف إستعماري واسع طيلة تلك السنوات، إلاّ أنه حاول الإستقلال عنه فيما بعد بشكل واضح وهذا ما يوضحه جيرار لكلرك في كتابه القيم " الإنتروبولوجيا والإستعمار".[10]
أما الإستشراق فقد إرتبط منذ نشأته بعوامل وظروف مختلفة ومرّ بمراحل وتطورات جعلته يقترب من الإنتروبولوجيا مع فارق في المنهج. فالمنهج الإنتروبولوجي منهج تأصيلي يفسّر المشتركات بين البشر بالعودة إلى الأصل المفترض رمزاً أو حقيقة أو تاريخاً أو فسيولوجياً، بينما التاريخانية التي تعتمد الفيلولوجيا النصية، أو التطورات التاريخية، هي التي تسود في الإستشراق. كذلك فإن الأمر الأكثر تعقيداً متصل بعلاقة الإستشراق بالسلطة أو بالأحرى بالسلطات الإستعمارية. ففي حين كانت إشكالية الإنتروبولوجيا مزدوجة أو مركبة من إزدواجين، كان هناك إزدواج من نوع آخر في الإستشراق. في الإنتروبولوجيا كان هناك إزدواج البدائي في مواجهة المتحضّر، والمستعمر في مواجهة الستعمر. بينما كان الأبرز في الإستشراق بحسب إدوارد سعيد وطلال أسد ومدرسة نقد الإستعمار النقيض الثاني: مستعمِر/مستعمَر. فحتى بعد الإستقلال، كان الإستشراق يمارس في دوائر الجامعات التي أنتجت الأطروحات الأساسية عن المجتمعات غير الأوروبية، وغير الحديثة بالمقاييس نفسها. وإدوارد سعيد، بل وميمي وفرانز فانون وكلاستر وغوشيه (وغيرهم من محرري مجلة Libre) يرون هذه الثنائية مهمة وأساسية في فهم أطروحات الإستشراق الأساسية. وفي الواقع فقد كانت هناك محنة منهجية- إذا صحّ التعبير- ذلك أن الإصرار على تاريخانية الإستشراق أو إعتباره جزءاً من تخصص الشرق القديم والوسيط، أو جزءاً من تاريخ العالم، أوشك أن يلحقه لدى الماركسيين الدوغمائيين أو الرسميين بالمراحل الأربعة المعروفة، فلا يبقى ما يمكن فعله. وقد إستمر هذا التجاذب والجدال، أو بعبارة أخرى التساؤل عن الإستشراق، وهل هو علم أم لا، إلى أن ظهرت مدرسة الحوليات ومدرسة التاريخ العالمي، فصار ممكناً دراسة هذه المنطقة من العالم بطريقة سياقية لا تنافي ذاتيتُها عالميتها، ولا يؤدي إلى إعتبار المسلمين كائنات إنتروبولوجية ما خضعت للتطور التاريخي.[11]
حين كتب أنور عبد الملك دراسته الهامة "الإستشراق في أزمة" عام 1963 كشف أن الإستشراق يعاني بطرائقه الفيلولوجية والتاريخانية من مواريث عصر الإستعمار ومن جهة ثانية كشف أنه لم يستفد أيضاً من الثورة الحاصلة في العلوم الإجتماعية والتاريخية. والواقع أن هذه الملاحطة الأخيرة في منتهى الأهمية، إذ أن كل مدرسة نقد الإستشراق فيما بعد لم تنتبه إلى أن هذا التخصص أو المجال يتعرّض لإختراق تدريجي وتحوّل لتسميته، وإطلاق عناوين أخرى عليه مثل دراسات إسلامية أو شرق أوسطية أو تحوّله إلى إتنروبولوجيا. وقد برزت في هذا المجال دراسات إرنست غلز Ernest Geller وكليفورد غيرتز Clifford Geertz وزملاؤه من أمثال جيلسنان Gilsenanوأيكلمان Eickelman، في حين إستمرت مدرسة Libre وإستمر طلال أسد وجيرار لكلرك وفرد هاليداي وسامي زبيدة[12]، في النظر إلى الإنتروبولوجيا في إطار النقد الإستعماري، كما إستمروا جميعاً يقرون الظواهر في ضوء هذه المقولة. وإنفرد طلال أسد بنشر نقد جذري لأطروحة :إنتروبولوجيا الإسلام"[13].
يرى غلز أن الجوهر الأصلي للإسلام أنه دين نصي أخروي يتميّز بنزوع طهوري شديد، هذه الطهورية يخفف من حدتها التقليد الأكثري للسنة الذي يظهر في صورة توازن بين الأعراف المدينية والسلطة والعلماء. ولكن في الأزمات يعود النص إلى البروز ويظهر علماء
متشدّدون يتسلحون بالنص من أجل إستعادة الطهورية أو البراءة الأولى، وهي لن تستعاد طبعاً، ولكن في التقابل بين المدينة والقبيلة فازت المدينة، وبقيت الشرعية لدى العلماء، حراس النص ومؤوّليه والقائمين على ضياع الجماعة الشعائرية والعرفية في مواجهة السلطة المهزوزة لدولة القوة والضرورة. وقد تكون الأزمة الحالية تعبيراً عن تقبّل الحداثة. بهذه الصيغة المعقّدة، فالمناضلون الأصوليون هم في هذا السياق بحسب غلز أولئك الذين يعيدون قراءة النص لتجديد التقليد والدخول في العصر.
يختلف غيرتز مع غلز في رؤيته العامة للإسلام، فبحسب غيرتز لا يمكن أن يحدث تغيير ما في المجتمع أو الثقافة إذا ما أخذنا برؤية غلز حول الدورات المكرورة على النص الواحد والمجتمع الواحد مع بقاء الجوهر ثابتاً كما يزعم. بل الأحرى القول أن المجتمع الإسلامي مثل سائر المجتمعات شديد الحركة والتغيّر. أما البنى والثوابت البادية فهي رموز، تبقى عناوينها وتتغيّر معانيها، وتنقطع أو تتضاءل علاقاتها بالواقع في الأزمات فيظهر التشدّد بسبب توتر المقدّس. فليس هناك مجتمع عالمي إسلامي، بل هناك مجتمعات إسلامية وتقاليد إسلامية متعددة لا تجمعها إلاّ رموز ومقدسات عليا، تُظهر وحدة أو شبه وحدة في الوعي، لكن لا علاقة في الواقع بين ما يحدث في المغرب، وما يحدث في أندونيسيا. وتحدث التطورات الإجتماعية والثقافية في المجتمعات الإسلامية مثلما تحدث في المجتمعات الأخرى التي لا تدين بالإسلام.
غلز وغيرتز هما الشخصيتان اللتان سادتا ما عرف بإنتروبولوجيا الإسلام في العقود الثلاثة الأخيرة. ويرى سامي زبيدة أن المستشرقين الشبان إنحازوا في الغالب إلى رؤية غيرتز أو رؤية كلاستر ولكلرك وطلال أسد، إلاّ أن قلّة فضّلت رؤية غلز لأنها مباشرة ويمكن إستعمالها بطريقة أسهل في حكم سريع على الإسلام.[14]
وهذا ما يفسّر إختراق الإنتروبولوجيا للإستشراق والعلوم التاريخية، فهي تملك منظومة تفسيرية متكاملة يمكنها أن تفسّر كل شيء في الظاهرة الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية.
- الإستشراق والسوسيولوجيا:
تسعى السوسيولوجيا إلى تحليل الدين بعيداً عن الفقه واللاهوت فتركز على الممارسة السلوكية في الواقع المعيشي وما تعتمد عليه المجموعات البشرية من معتقدات وتفسيرات للنصوص الدينية من منطلق مواقع البنية الإجتماعية. منطلق السوسيولوجيا وعلم الإجتماع يختلف منهجياً عن الإستشراق، فالأول يسعى إلى تحليل السلوك الديني في الحياة اليومية وما يستند إليه من تفسيرات خاصة للنصوص الدينية في السياق الإجتماعي والتاريخي، ومن منطلق التناقضات والصراعات القائمة داخل المجتمع وفي علاقاته بمجتمعات وحضارات أخرى، في حين يذهب الإستشراق بإتجاه تقديم تفسيرات خاصة للنصوص والوقائع والأحداث الدينية في الشرق بمعزل عن سياقها الإجتماعي والتاريخي، فعلياً الخلفية المعرفية الغربية التي ينطلق منها ودون أن يستعمل أدوات منهجية تحدّ من الإنحيازات المنهجية الفاضحة التي أصابت بعض دراساته.
والواقع أن السوسيولوجيا ترى الدين ظاهرة منبثقة من واقع إجتماعي وإقتصادي وسياسي وتاريخي شديد التعقيد يتطور بتطور هذا الواقع وهو يتصل بدور المؤسسات والبنى الإجتماعية (كالعائلة والطبقات والمؤسسة السياسية وغيرها) إتصالاً عضوياً وتفاعلياً، وهو يقوم بوظائف محددة ويلبي حاجات ظاهرة وخفية وقد تكون توظيفاته إيجابية أو سلبية، وكثيراً ما تكون التأويلات الدينية متنوعة بل متناقضة، وقد يتحوّل الدين من طاقة روحية ثورية في مراحل التكوين الأولى إلى مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية، ثم تحصل الإنقسامات والتناقضات ليس بسبب التنوع في المعتقدات بحد ذاتها، بل بسبب التناقضات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد يستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة في تثبيت شرعيتها وهيمنتها، أو من قبل القوى المعارضة للتحريض وإثارة السخط ضد النظام القائم، كذلك ليس بالإمكان إستعادة الماضي مهما كان ذلك مستحباً، وذلك لأن القيم والأفكار والمعتقدات تنبثق من واقع معين ولا يمكن فرضها من الخارج على واقع مخالف للواقع الذي نشأت فيه أصلاً من دون تطويرها والتخلي عن بعضها.[15] لهذه الأسباب كلها تنوعت القراءات والتحليلات عند علماء الإجتماع في الظاهرة الدينية، وهم لا يتفقون حول أصول الدين وطبيعة وظائفه في المجتمع ونوعية علاقته بالبنى الإجتماعية والإقتصادية والنظام السائد. يؤكد هيغل أن الأفكار والمعتقدات، أي البنية الفوقية هي التي تحدد السلوك الإنساني. وعلى العكس من ذلك تماماً يؤكد كارل ماركس على أن نمط الإنتاج والأوضاع الإقتصادية أو البنية التحتية هي التي تنشأ عنها الأفكار والمعتقدات. وبين هذين النقيضين يقف ماكس فيبر الذي يتراوح فكره بين التشديد على أولوية الأفكار والمعتقدات، كما في كتابه: الأخلاف البروتستانتية وروح الرأسمالية (وهو بذلك أقرب إلى هيغل) وعلى التفاعل بين الثقافة والبنى الإقتصادية، كما في كتاباته حول التنظيم الإجتماعي والإقتصادي، وعلى تغليب العوامل المادية في معالجته الجانبية للإسلام (وهو بهذا أقرب إلى ماركس).
لقد شدد عالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر (1864-1920) في معالجته للإسلام، على عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق البوتستانتية ونشوء الرأسمالية في أوروبا، على الصلة الوثيقة بين الدين (خصوصاً الإسلامي) والسلوك اليومي الهادف ذي المضمون الإقتصادي، فقال في كتابه علم إجتماع الدين كلاماً يذكرنا بالتفسير الماركسي المادي: "إن غايات الدين...هي على الأغلب إقتصادية"[16]، وهو يرى أن دعوة النبي محمد r إكتسبت أهمية إجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في ضوء نمط معيشتهم ومصالحهم الإقتصادية. وبذلك إعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات الإسلامية، جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة. وبكلام أدق إعتبر الإسلام زواج بين القيم التجارية والقيم الفروسية البدوية والقيم الصوفية المعبرة عن عواطف الجماهير وحاجاتها، ونتيجة لهذه المزاوجة الثلاثية، وجهت الطبقة المحاربة الإسلام بإتجاه الجهاد والأخلاقية العسكرية، ووجهته الطبقة التجارية في المدن بإتجاه التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية، ووجهته الجماهير المستضعفة بالإتجاه الصوفي والهرب الضبابي[17]. وقد ساهمت هذه القيم التقليدية بإستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة، وهو ما أسماه فيبر الولاء والطاعة للسلطان-الحاكم Patrimonialism الذي يحصر القرارت بشخصه مدعياً أنه ظلّ الله على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين المدنية. أي أن فيبر رأى تعارضاً بين الإسلام وروح الرأسمالية ونشوء المؤسسات بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين.
لم يقلل براين ترنر في نقده لآراء فيبر من أهمية العوامل الإجتماعية والإقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره، بل ركز على جوانب معينة، منها الفراغ السياسي الذي حلّ في المنطقة حينها نتيجة الصراع البيزنطي- الفارسي الذي أضعفهما معاً فأدّى لبروز الإسلام وإنتشاره، وبروز مكة ثانياً كمركز تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية، الأمر الذي أدّى إلى تطورات بنيوية في الجزيرة العربية كان من بينها إنحلال القيم التقليدية وبدء إنتشار قيم الكسب والجاه والرفاهية الفردية. في هذه المرحلة الإنتقالية نشأت حالة البحث عن الخلاص والإستعداد النفسي لتقبّل قيم بديلة، وهذا ما قدّمه الإسلام، فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت تعيشه الجزيرة العربية آنذاك.
من بين الباحثين الرواد في حقل علم إجتماع الدين جورج سيمل George simmel (1858-1918) إعتبر أن الكثير من المشاعر والتعبيرات التي تنسب للدين هي عناصر جوهرية من عناصر التفاعل الإجتماعي عامة، فالتأليه والإلتزام والعبادة والمحبة أمور مشتركة في كل أشكال التجارب والعلاقات الإنسانية في مختلف العصور والمجتمعات قبل ظهور الأديان وبعدها، من هنا يرى أهمية دراسة دور المجتمع في نشوء الدين وتطوره. وهذا ما ذهب إليه عالم الإجتماع الفرنسي إميل دوركايم (1858-1917) الذي إعتبر أن "روح الدين" هو في الواقع "فكرة المجتمع" نفسه، وهو رمز المجتمع والمعبّر عن وحدته وعصبيته. إن إله العشيرة نفسها مشخصنة أو ممثلة بالإله بحسب التصور الإنساني، وبذلك تكون وظيفة الدين الأساسية هي تعزيز وحدة المجتمع وإعطاء الشرعية لقيمه ومعاييره وإضفاء القداسة عليها وبتجميع الناس معاً في هدية موحدة من خلال ممارسة الشعائر والطقوس الدينية. وبحسب دوركايم إن ما نسميه الأديان "الله" هو في الواقع المجتمع نفسه، ويستدل على ذلك من مفاهيم الطوطم ومبادئ الطوطمية التي لها شأن كبير في التنظيم والتماسك الإجتماعيين. والطوطم هو جسم ورمز للأب أو الجدّ الذي يتحدّر منه أفراد القبيلة فينظرون إليه بإحترام وخشوع. وهذا الطوطم ليس مهماً بحدّ ذاته، بل بما يمثّل أنه رمز لروح القبيلة وإستمرارها، والمعبّر عن شخصيتها وهويتها، بل إن المجتمع يتجسّد في الطوطم والألهة فيكون هو موضع العبادة، وذلك لحاجة المجتمع أن يؤكد ذاته بذاته ويرسخ شرعيته وقيمه. وبحسب هذه الرؤية يكون الله صورة المجتمع وليس المجتمع صورة الله.[18]
أكّد دوركايم على الوظيفة الإيجابية للدين وهي التماسك الإجتماعي، لكن كارل ماركس ركّز على سوء إستعمال الدين من قبل المؤسسات والطبقات المهيمنة من حيث الدعوة لترسيخ قيم الصبر والمصالحة مع الواقع المرير، فإعتبره من هذه الناحية "أفيون الشعوب" لأنه يشجع الضعفاء على تقبّل أوضاعهم والإستكانة لها بدلاً من العمل على تغييرها.
أما علماء الإجتماع المعاصرين فقد تابع قسم منهم تحليل الظاهرة الدينية على مستوى الماكروسوسيولوجي Macrosociology فقدم بيار بورديو قراءته على ضوء مفهوم الحقل الديني الذي هو كباقي الحقول (الإقتصادية والسياسية والفنية...) على الرغم من إستقلاله النسبي، إلاّ أنه لا يمكن إدراك بنيته إلاّ من خلال التفكير فيه علائقياً. فالحقل هو جملة متشابكة، هي عبارة عن مواقع وسلطات أو مواقف وخيارات أو مصالح وإستراتيجيات أو رهانات وإستثمارات، هذه العناصر تدخل في تركيب الحقل على نحو يجعل منه "بنية تفاضلية" تعمل بحسب مبدأ أساسي يقوم على " توزيع أنماط السلطة وأنواع رأس المال". ورؤوس الأموال على نوعين كبيرين: رمزية كالمعتقدات والمنتوجات الثقافية والعلمية، ومادية كالأموال والموارد الطبيعية والسلع الإستهلاكية والمنتجات التقنية. والسلطات كذلك على نوعين "مادية" تتمثّل في مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش والقضاء و"رمزية" تتمثّل في السلطات الثقافية من دينية وخلقية وأدبية. الأولى تمارس العنف الفيزيائي والثانية تمارس العنف الرمزي بأجهزتها الإيديولوجية، الأمر الذي يجعلنا أمام نوعين من الشرطة: شرطة أمنية تقوم بحراسة الأجساد والممتلكات، وشرطة فكرية تقوم بحراسة القيم والمعتقدات[19].
والواقع بيار بورديو يعتبر من أواخر علماء الإجتماع الذين قدموا ما يمكن أن نطلق عليه مقاربة ماكروسوسيولوجية ممثلاً للإتجاه الشمولي في الدراسات الإجتماعية Holistic approach، فقد حصل تحوّل بعده في الدراسات الغربية، ساد فيه من المقاربات الميكروسوسيولوجية Microsociology والإتجاه الذري التجزيئي Atomic Approach، وهو ما يشكّل مأزقاً خطيراً للدراسات السوسيولوجية لأنه يؤدي إلى طغيان النزعة التجريدية الكمية في العلوم الإنسانية ويجعل الظاهرة الإجتماعية تفلت من التحليل الشمولي الذي يربطها بالبناء الإجتماعي ككل. وبالتالي شكلت معالجة الظاهرة الدينية لدى الغربيين إنطلاقاً من هذه المقاربة مأزقاً مستعصياً جعلهم غير قادرين على تقديم تفسيرات عميقة لما يجري في العالم الإسلامي في تعميق تخلّف الدراسات الإسلامية في الغرب.
- ميلاد الإسلامولوجيا الجديدة:
مع ذلك لا يمكن أن نعمم بشكل مطلق هذه الملاحظة، ولكن هناك تيار جديد نشأ بلا شكّ وهذا ما يوضحه أوليفيه روا، وهو أحد أبرز الباحثين الفرنسيين في مجال الإسلامولوجيا، وهو من أقطاب "الإستشراق الفرنسي الجديد". فيقول : "إنتقلت الدراسات الإسلامية عندنا من فترة المستشرقين الكلاسيكيين الذين كان إهتمامهم منصبّاً أساساً في التخصص في مجالات دراسة القرآن والتاريخ الإسلامي واللغات والآداب الشرقية، أمثال مكسيم رودنسون وجاك بيرك وكلود كاهين، إلى جيل جديد من الباحثين المتخصصين أساساً في السوسيولوجيا والعلوم السياسية. هذه الفئة الجديدة من الباحثين لا ترى أن الدراسات الفقهية القرآنية أو التاريخية هي أداتها الرئيسية في دراسة الظواهر الإسلامية المعاصرة وتحليلها، بل المحكّ بالنسبة لها هو البحوث الميدانية. المستشرقون الكلاسيكيون كانوا يرون أن تعلّم ودراسة القرآن والتخصص في مجال التاريخ الإسلامي هو المفتاح العلمي الذي يؤهلهم لفهم الظواهر الإسلامية وتحليلها، بما في ذلك المعاصرة منها. أما جيلنا الحالي، فقد تجاوز هذه النظرة الضيّقة وأصبحت دراسة القرآن والتاريخ واللغات والآداب الشرقية بالنسبة لنا لا تعدوا أن تكون أدوات بحث نستعين بها خلال تنقلاتنا وأسفارنا ودراستنا الميدانية. ونحن بخلاف الكلاسيكيين لا نسعى لفهم الظواهر الإسلامية المعاصرة في ضوء دراسة التاريخ أو الفقه أو الآداب القديمة، بل تنعامل مع هذه الظواهر التي ندرسها من خلال أدوات البحث العلمي التي نعتمدها لتحليل أي ظواهر إجتماعية أو سياسية أخرى ندرسها شرقية كانت أم غربية. لكن هذا لا يعني أن هذا الجيل من الباحثين له نظرة واحدة وآراء متوافقة في مجال الإسلاميات والإستشراق، بل لكل واحد منهم خصوصيته وتوجهه وأفكاره، أما السمة المشتركة التي جعلتهم يؤلفون ظاهرة متميزة فتكمن في كونهم جميعاً متخصصين إما في السوسيولوجيا أو في العلوم السياسية، وهو ما يجعلهم يغلبون دوماً الدراسة الميدانية على دراسة النصوص[20]. لا شكّ أن هذا الجيل من الباحثين في الإسلامولوجيا لم ينطلق من الفراغ، فهم ليسوا أول من إعتمد المقاربة السوسيولوجية الميدانية في مجال الإستشراق، فالمستشرق الفرنسي الكلاسيكي مكسيم رودنسون ولأنه كان يحمل أفكاراً يسارية كان له إهتمام خاص بالحركات والظواهر الإجتماعية، كذلك كانت اللبنات الأولى مع الرواد خلال الحملات الإستعمارية الذين خولتهم مهامهم إجراء أبحاث سوسيولوجية وإنتروبولوجية لإستيعاب خصوصية الثقافات المحلية للمجتمعات الإسلامية التي عايشوها، وهو ما جعلهم لاحقاً مناصرين لقضايا التحرر الوطني لشعوب المستعمرات الفرنسية السابقة كجاك بيرك وريمي مونتاني كنماذج بارزة في طليعة منظري وصناع ما يعرف بـ " السياسة العربية" لفرنسا لاحقاً.
يرى اوليفيه روا أن التحول الذي حققه الجيل الجديد من المستشرقين يعود لعدّة أسباب أهمها خصوصية الإستشراق الفرنسي المغاير للتجربة الإنغلوساكسونية والتي يمثّلها اليوم برنارد لويس، والقطيعة التي تعمّقت أكثر، بفضل ما إكتسبناه نحن الأكاديميين من استقلالية فكرية وتحويلية، ومن هامش نقدي تجاه المؤسسات الرسمية ومراكز القرار السياسي والعسكري. ينتقد أوليفيه روا أعمال برنارد لويس بشدّة لأنه لا يزال يعتمد الأدوات الكلاسيكية الأمر الذي أدّى به إلى الإرتماء بأحضان المحافظين الجدد وإتخاذه مواقف عدائية من الإسلام والمسلمين، كما ينتقد بنفس الوقت أعمال بعض الأميركيين من نفس الإتجاه المناصرين للإسلام أمثال جون اسبوزيتو، معتبراً أن الخلل البحثي في كلتا الحالتين يكمن في أن الظواهر الإسلامية الراهنة لا يمكن تفسيرها أو فهمها في ضوء النصوص الفقهية وحدها، أو بإسترجاع التراث التاريخي الإسلامي وتحليله فقط، بل يجب قبّل كل شيء وضع كل تجربة إسلامية في سياق الظرف الإجتماعي والسياسي المعاصر الذي يحيط بها. فهذه هي المقاربة الوحيدة كما يقول، التي تجعلنا نفهم كيف يمكن أن يكون شخصاً أو تياراً إسلامياً معتدلاً، فيما أشخاص أو تيارات أخرى متطرفة أو أكثر راديكالية، مع أنهم جميعاً ينطلقون من نص قرآني واحد ومن مرجعية فقهية مشتركة.
أوليفيه روا قدم مجموعة من الأبحاث الهامة كنماذج عن هذا الإتجاه الجديد منها مثل الإسلام السياسي (1992)، جينالوجيا الحركات الإسلامية (1995)، آسيا الوسطى الجديدة أو مصنع الأمم (1997)، إيران: كيف يمكن الخروج من ثورة دينية (1999) نحو إسلام أوروبي(1999)، الشبكات الإسلامية (2002)، تركيا اليوم هل هي بلد أوروبي (2004)، عولمة الإسلام (2002).
في كتابه عولمة الإسلام يرصد بدقّة تحولات الظاهرة الإسلامية فيما يتعلّق بالعولمة ويقدّم أمثلة دالة على الإنخراط في ديناميات العولمة حيث بدأت الحركات الإسلامية تتجاوز مشكلة الثقافة وتتفاعل مع الثقافات الفرعية، تساعدها على ذلك ثورة الإتصالات، إقتصاد السوق، أنماط جديدة للمجتمع، تراجع الدولة الوطنية. فيلاحظ أن الإسلاميين استفادوا كثيراً من ثورة المعلومات وهم الأكثر توظيفاً لمعطياتها، ويرصد ظاهرة الدعاة خارج المؤسسة الدينية، والتعليم العصامي، وتوظيفهم للتقنيات الحديثة مما يؤدي إلى ضرب النظرية التقليدية الإسلامية في تحصيل المعرفة. ثم يرصد ظاهرة الإنفتاح على السوق فلا يجد ممانعة لدى الإسلاميين للخصخصة وإعادة الهيكلة وانسحاب الدولة من الإقتصاد، وتحت عنوان مصالحة الدين والثروة يلاحظ كيف كانوا في السبعينات يأتون إلى الإسلام من أحزمة الفقر وكانت فكرة العدالة الإجتماعية في الأولويات في حين لم تعد هذه القضية من نفس المستوى، ويتابع راصداً دخول الدعوة الإسلامية نفسها منطق السوق، فيتحدّث عن إقتصاديات نشأت حول الظاهرة بدءاً الكاسيت إلى محلات الحجاب إلى البنوك الإسلامية وأشكال الإستثمارات. كما يرصد حالة دينية متزايدة في الطبقات العليا والبورجوازية. وبعد أن كانوا ضدّ حقوق الإنسان صار هناك الآن (حركة سواسية-إخوان) فتمّ إنشاء مراكز يتم التفاعل معها في مساحة مناهضة للعولمة-مما يعني أن تفهم الإسلاميين لدور المنظمات العالمية يحصل دون مشكلة وبشكل تدريجي.
في الواقع نجد داخل هذا الإتجاه الجديد توجهات وتيارات معقّدة منهم فرانسوا بورغا وهو باحث نشيط وذو إتجاه يساري مناصر لقضايا العالم الثالث، كذلك ميشال سورا الذي غيّبه الموت مبكراً في بيروت وكان باحثاً واعداً، وأيضاً جيل كيبيل الذي سنعرض لبعض أعماله.
وتعتبر الدراسة التي قدّمهابرنار روجيه (1993) نموذجاً لهذه الدراسات (الإخوان والجامع في الجزائر، إستطلاع للحركة الإسلامية في الجزائر) وهي دراسة ميدانية في مدينة قسنطينة وبعض المدن الجزائرية، يرى فيها أن الجوامع كانت محور العمل والحجرات الحقيقية لفهم معظم التناقضات الإجتماعية، وينطلق رواجيه من تساؤل حول معنى تكاثر الجوامع والمساجد بالنسبة إلى مجتمع لا يزال يعاني من آثار حرب مدمرة، وكيف ينظر لها محركيها الروحيين وداعميها، وما هي أدوارها الدينية والإجتماعية التي بنيت لأجلها؟ وقد إنطلق في دراسته من تجاوز المظاهر والخفايا حول الدين إلى الممارسات العقلية التي كان الفاعلون الإجتماعيون يمارسونها وخصوصاً في إطار إنماء المساجد والجوامع[21].
أما جيل كيبيل فهو من أبرز الوجوه في هذا المجال أيضاً وصاحب إنتاج غزير، وقد صدرت له مجموعة دراسات منها النبي والفرعون (1984)، وضواحي الإسلام (1987)، ويوم الله (1992)، غربي الله (1995)، والجهاد (2000)[22].
وكتابه هذا يعتبر من أنضج كتبه والأطروحة المركزية التي يحتويها يتكأ في تأويلها على مفاهيم سوسيولوجية نجد معالم بعضها عند ماركس فيبر (فيما يتعلق بالدين والمدينة ودور المؤسسة الدينية) وعند بيار بورديو (فيما يخصّ "الحقلين" الديني والسياسي)، والأطروحة هذه هي التي تشرح مكونات التيار الإسلامي وتبحث في الفئات الإجتماعية والثقافية التي حملت لواءه. فترى أن هذا التيار تكون من ثلاث قوى هي الشباب المديني الفقير، والطبقة الوسطى المتدينة، والإنتلجسيا الإسلامية. القوة الأولى أي الشباب المديني الفقير تشكّلت بعد الإنفجار السكاني وهجرة الأرياف إلى المدن في الخمسينات والستينات وأنشأت الضواحي وسكنتها. وما يميّز هذه الفئة هو حصولها وللمرة الأولى في تاريخ الطبقة التي تنتمي إليها على التعليم نتيجة سياسات الحكومات المتبعة يومذاك والتي تعزّز القطاع العام وأنشطته التعليمية. غير أن هذه القوى الشابة المتعلّمة نسبياً لم تجد إلى سوق العمل وإلى الإرتقاء الإقتصادي والإجتماعي سبيلاً، فأضيف إلى قهر ظروفها الطبيعية شعور بالغبن والحرمان وحنق على النظام حرماها العدالة الإجتماعية. ولما كان أبناؤها جميعاً جميعهم من مواليد العقد الذي تلا الإستقلالات الوطنية، ومن الذين شهدوا هزيمة الأنظمة القائمة أمام إسرائيل، سقطت مشروعية هذه الأنظمة في نظرهم لفشلها على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.
وبدءاً من العام 1970 تاريخ رحيل جمال عبد الناصر وتراجع المشروع القومي العربي راح هؤلاء الشباب يبحثون عن "فكر بديل" فإكتشفوا الفكر الإسلامي بنصوصه المنتجة في الستينات، وخصوصاً أفكار سيد قطب في إستعادته لأفكار حسن البنا وأبو الأعلى المودودي، ثم كانت أفكار الخميني وشريقي في إيران. وقد رافق التحول في القراءة والإستلهام العقائدي تبدل عميق في التركيبة الديموغرافية، بحيث يصبح سكان المدن المتوسعة الأكثرية للمرة الأولى في تاريخ العالم الإسلامي. وانعكس هذا التبدل على نحو حاسم في علاقة الناس بالدين ونصه، إذ باتوا مستقلين في علاقتهم به عن "المعممين"، الذين هم الوسطاء الوحيدون في الأرياف والمدن الصغرى، ومستقلين عن القرار السياسي للمؤسسة الدينية المرتبطة غالباً بالسلطة، ويمكن القول أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان يعني بالنسبة إلى هذه الفئة الفقيرة إحلال العدالة الإجتماعية الحقيقية وقلب الأنظمة التي تعوّق ذلك.
القوة الثانية المكونة للتيار الإسلامي أي الطبقة الوسطى المتدينة، عانت بدورها من الأنظمة القائمة، وإن كانت "معاناتها" مختلفة. فأبناؤها من التجار (البازاريون) وملاك الأراضي الذين نزعت منهم ملكيتهم عقب سياسات التأميم، وهم في أكثريتهم من المهمشين سياسياً، إذ أقصاهم العسكر أو الملوك عن السلطة ومرافقها. وإنضم إليهم في السبعينات بعض "المهنيين" الذين راكموا ثروات في الخليج العربي إثر الطفرة النفطية واكتشفوا الوهابية واعتنقوها، وراحوا بعد عودتهم يستثمرون في البنوك الإسلامية، ويقيمون الأنشطة والمشاريع الخيرية. ويجمع هؤلاء شعور بأن لا فضب لـ "دولهم" عليهم وعلى إرتقائهم الإجتماعي، ولا نية لديها لتقريبهم من مراكز القرار فيها. وهم يرون ضرورة التحالف مع القوة الأولى (الشباب المدينيون الفقراء) من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، لا طمعاً بالعدالة الإجتماعية بل بهدف قلب الأنظمة والإمساك بالسلطة. أما القوة الثالثة، أي الإنتلجسيا الإسلامية، فمكونة من مثقفين إسلاميين شكلوا "الخميرة" التي تضاف إلى القوتين الأولى والثانية لتقربهما الواحدة من الأخرى، وتطلق خطاباً يكون محور التحالف بينهما، وهو خطاب يجانب القضايا الإجتماعية ويركز على السياسة والأخلاف هرباً من إتخاذ موقف "طبقي" ينفّر إحدى القوتين الأوليين منه. بتحالف هذه المكونات الثلاث وتكاملها نهض التيار الإسلامي ونمت الحالة الإسلامية في السبعينات والثمانينات كما يرى جيل كيبيل، ثم انفكّ عقدها وبدأ التراجع في التسعينات. وتراجع الظاهرة الإسلامية عنده لا يعني نهايتها، بل يعني فقدانها ديناميتها الأساسية، أي قدرتها على جمع الطبقات الإجتماعية المختلفة ودفعها إلى حمل مشروع سياسي مشترك. كما أن الصراعات التي تفجرّت في التسعينات ساهمت في تنامي الإنقسام والتفتيت داخل الحركة الإسلامية الأمر الذي ساهم في تأكيد الإنحسار الذي يتحدّث عنه كيبيل.
يقدم الباحث السويسري باتريك هايني نموذجاً شيّقاً من هذه الكتابات، فيرصد في كتابه "إسلام السوق"[23] جانباً مغيّباً من الظاهرة الإسلامية المعاصرة غفل عنه الدارسون، في الوقت الذي تتنافس فيه وسائل الإعلام ومراكز البحث في الكتابة على ما يسمى الإسلام السياسي. وإنطلاقاً من مصر ومروراً بإندونيسيا وانتهاءً بتركيا، يحلل "إسلام السوق" بزوغ شكل جديد من أشكال الكينونة الإسلامية تخرج من صلب إسلام سياسي ظهر عليه التعب، أو تمر محاذية له، تشترك معه في المنبع لكنها تختلف معه في الهدف والوسيلة وتحديد مجالات العمل.
في بداية كتابه يشخّص هايني إزدياد الإسلاميين الغاضبين الذين ينتقدون في الآن نفسه الإيديولوجيات الإسلامية ليقينيتها، وبنيانها التنظيمية بجمودها وقسوتها، ولكن دون أن يصل هذا الموقف بأصحابه إلى مغادرة الحقل الإسلامي، بل يدفعهم هذا إلى البحث عن طريق للخلاص الفردي وتحقيق الذات والنجاخ الإقتصادي. ويثير المؤلف الإنتباه إلى التنافس بين الدعاة الجدد في إستثمار موجه الصحوة الإسلامية المنفلتة من قبضة التنظيمات الإسلامية والمستعصية عليها، وسعي هؤلاء الدعاة إلى إنجاز مصالحة توفيقية بين المدّ الديني والحداثة الغربية، ويحدث هذا من خلال عدّة مسائل وتعادلات دعوية تستخدم الطرق الأميركية في الدعاية، وتشجع ميلاد فرق موسيقية عصرية ووجوه دعوية نسائية حديثة ويستعرض أربع سيناريوهات:
- تجازو الإسلام السياسي حدث عندما تجمّد التدين النضالي وشعر المنخرطون فيه بالجمود التنظيمي، فوجدوا الحل بالإنفتاح على العصر و"أسلمة" منتجاته، وهكذا يتحول الجهاد عن مكانه ليصير جهاداً إلكترونياً، ويتابع قصّة ظهور النشيد الإسلامي من بداياته الملتزمة وتعبيره عن قضايا الأمة إلى ظهور الفرق الغنائية الحديثة التي صارت تمتهن الدعوة بالموسيقى، وفي المسار نفسه يرصد كيف إنخرطت الحشمة الإسلامية وزيّها الخارجي لتنتقل من الحجاب المناضل ذي الرمزية السياسية إلى الإستهلاك الجماعي والتأثر بالموضة. ويقدم المؤلف تركيا نموذجاً إسلامياً للإندماج في إقتصاد السوق وبروز برجوازية إسلامية تصنع فضاءً إعلامياً جديداً تلتقي فيه العولمة بالإحيائية الدينية الإسلامية، وتغيّر الحشمة من وجهها وملامحها وألوانها وأشكالها، ثم يتوج كل ذلك بالموجة الثالثة من الحجاب في الإسلام الأوروبي. ثم تظهر القنوات الفضائية متأثرة بالتجربة الإعلامية الإنجيلية الأميركية، لدى نجمين من نجوم الوعظ التلفزيوني وهما المصري عمرو خالد والأندونيسي عبد الله جمنستيار، فالأول إكتسب الطريقة من متابعة الوعاظ الأميركيين في قنواتهم، والثاني دربه عليها واعظ أميركي إنجيلي سابق إستطاع مضاعفة أعضاء كنيسته في عامين فقط بفضل تقنيات التسويق الإعلامي، قبل أن يعتنق الإسلام عام 1997 ويصير مستشاراً لجمنستيار.
- قانون السوق يفرض نفسه في علاقة الإسلاميين الجدد برجال الأعمال والإقتصاد، فقد وجد هؤلاء أن السوق هو القناة الوحيدة للتعبير. وأن السوق لم تعد وظيفته الترويج للأفكار وإقناع الرواد بها فقط، ولكن صارت أيضاً تلبية طلبات الجمهور المستهدف واغلبه من البرجوازية المتدنية الكارهة لكل نضال ذي محتوى سياسي بالمعنى الأصيل أو بالمعنى الدخيل. ويضرب المؤلف المثال بتجارة الأشرطة الدينية في القاهرة والتي تظهر أن مقاولات الإنتاج والترويج تستطيع تجاوز البنيات السلطية الموجودة وتسعى إلى الإقناع عن طريق الإغراء، بل إن الوعاظ الجدد لا يجدون مانعاً من الظهور في قنوات تجارية محضة أو غير إسلامية، وهي بدورها تشتري حقّ البثّ لأغراض تجارية بحتة. قانون السوق يستطيع إلحاق الهزيمة بالسلفيين أيضاً فيلجون عالم التسويق " التسويق الأخلاقي" –حسب تعبيرهم- والسوق الحلال خاصة في تجارة الملابس. وما أن يستغني رواد هذا السوق حتى يفكروا في الهجرة من ضواحي المدن الغربية المهددة بخلايا القاعدة، لا للعيش في البلدان الأصلية، بل للإستقرار في بلدان الخليج حيث يوجد الطلب على السلع العروضة.
- عقيدة الرفاهية يفرد لها فصلاً يرصد فيه جهد رواد إسلام السوق للمجتمع بين التقوى والغنى. فيبيّن كيف أن عبد الله جمنستيار يصرّ على أن رسول الإسلام (صلعم) كان رجل أعمال ناجح، ويكتب عمرو خالد أن الثروة والغنى وسيلة لإتقان التديّن وتقديم نموذج جيّد، ويدافع الإسلاميون الأتراك المقربون من حزب العدالة والتنمية عن أن القرآن الكريم يدعو إلى تكديس الثروة وأن الفقر يؤدي إلى الكفر. وفي السياق نفسه يؤسس الوعاظ المرشدون الجدد لعقيدتي الرفاهية والتنمية الفردانية متأثرين بالكاتب الأميركي ستيفن كوفي صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية والعالم (العادات السبع للناس الأكثر فعالية).
- يرصد هايني توجه الحركة الدينية الليبرالية الجديدة التي إستطاعت أن تشطب مطلب الدولة الإسلامية من قائمة الأهداف كما روجت لذلك الحركة الإسلامية طويلاً، فيرى أنها إستطاعت أن تعيد الإعتبار إلى المجتمع المدني ضد مفهوم الدولة الراعية المهيمنة على كل شيء واستطاعت إنشاء عدّة مشاريع ناجحة في العالم العربي والإسلامي، وصار الهدف لديها إنشاء "مجتمعات مدينة فاضلة" تشبه في طريقة عملها المؤسسات الدينية الأميركية الموازية للحزب الجمهوري الأمي
ما زال هناك تقصير على المستوى السوسيولوجي في دراسة الإستشراق، فبإستثناء عمل إدوارد سعيد[1] وهشام جعيط وأنور عبد الملك[2]، فإن الدراسات المتعمقة في تحليل تطور البنى المعرفية الإستشراقية وربطها بالبناء الإقتصادي والإجتماعي وبالتطور التاريخي تكاد تكون معدومة. من هذا المنطلق فإن هذه الورقة هي مجرّد محاولة أولية لتحليل الأطر الإجتماعية للمؤسسة المعرفية الإستشراقية عبر تطورها التاريخي مع قراءة لأبرز طروحات هذه المؤسسة ومقارباتها للموضوع.
- الإطار السوسيولوجي للمعرفة الإستشراقية:
لعبت الحركة الصليبية في عصر الإقطاع دوراً تأسيسياً في رسم معالم العلاقة بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فقد جسّد المشروع الصليبي النواة الصلبة لحركة عدائية عملت على تأسيس الشرخ العميق والهوّة التي فصلت بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق يدخل الزمن الصليبي في صلب العلاقة التاريخية المتوترة والعدائية التي وضعت الإسلام دائماً في حالة دفاع متواصل ضد الغرب الذي أفزعته إنتصارات وفتوحات الإسلام. إلاّ أن الأهداف الحقيقية للمشروع الصليبي لم تكن مجرّد إستجابة لضرورات دينية، وإنما كانت في جوهرها تحقيق لأهداف وأطماع تجارية وإقتصادية في الشرق من جهة، وتجسيد مادي وتاريخي (فوبيا phobia) أوروبية إيديولوجية من هذه القوّة المتصاعدة من جهة أخرى فقد " شكّل المسلمون بالنسبة للغرب المسيحي لفترات طويلة، خطراً قبل أن يصبحوا معضلة"[3].
من هنا يصبح من الضروري وضع الدافع الديني في إطار هذه الدوافع الرئيسية التي تحكمت إلى حدّ بعيد بمسار الأحداث ونتائجها والتي يميل البعض إلى تجاوزها والتقليل من شأنها.[4]
والواقع أن الدافع الديني لم يكن سوى ذريعة لتغطية الدوافع التجارية والإقتصادية والسياسية الكامنة في المشروع الصليبي، وهذا ما يؤكده العديد من الباحثين والأكاديميين والمؤرخين العرب والأجانب الذين أرّخوا للمرحلة الصليبية.[5]
ترافق هذا الأمر مع نوع من الإضطهاد والفقر شهد أوروبا عانى منه الفلاحون والأقنان أكثر طبقات المجتمع الإقطاعي حرماناً بسبب إستبداد رجال الإقطاع وتسلطهم، ومما زاد الأحوال الإقتصادية تردياً سوء المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والمجاعة وإنتشار الأوبئة والأمراض، الأمر الذي أرهق كاهل هذه الطبقات وزاد من بؤسها. بالإضافة إلى ذلك فقد كان لفوضى الصراع الإجتماعي بسبب الحروب الداخلية المتواصلة بين الأمراء الإقطاعيين الدور الفعال وتفاقم هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة. لقد دفعت هذه الأزمة التي سبقت المشروع الصليبي مباشرة الكثير من أبناء هذه الطبقات إلى المشاركة في هذا المشروع أملاً بالخلاص من ظروفها المعيشية السيئة.[6] لقد هيأت هذه الظروف جميعها مناخاً مناسباً للسلطة الدينية لإستغلاله في تحقيق مشروعها الصليبي، الذي تحوّل إلى سياسة خارجية شبه وحيدة للبابوية. هذه الخلفية التاريخية تمثّل الإطار الإقتصادي والإجتماعي وبدونها لا يمكن تناول المعرفة المتعلقة بالشرق من حيث المحتوى والشكل والسياق، سوسيولوجيا المعرفة، سواء مع كارل مانهايم أو ماكس شيلر، أو ماركس فيبر لا تكتفي بتحديد البعد السوسيوتاريخي للمعرفة بل لا بد من ربطها بالوظيفة الإجتماعية وبالأطر الإجتماعية الإقتصادية التي إنبثقت عنها والدور الذي يقوم به هذا المحتوى أو الناتج المعرفي في خدمة النظام الإجتماعي والسلطة الحاكمة فيه.
ولما كانت المؤسسة الكنسية أقوى المؤسسات نفوذاً أو سلطة في عصر الإقطاع، فمن الطبيعي أن يكون محتوى المعرفة المتعلقة بالشرق أثناء الحروب الصليبية وفي أعقابها محتوى دينياً منسّقاً في مجمله مع الأوضاع الإجتماعية التي سادت مرحلة الإقطاع من جهة، والرامية إلى خدمة هذه المؤسسة الدينية/ الكنيسة من جهة أخرى. ففي هذه الفترة التاريخية من تطور المجتمع الغربي شكّل الدين نظاماً إجتماعياً متكاملاً تداخلت في تكوينه عناصر إجتماعية وإقتصادية وتاريخية أهّلته للقيام بوظيفة الدفاع العام لتحقيق التضامن الجماعي بين أفراد المجتمع ضد الإسلام.
إنطلاقاً من هذه الخلفية لجأت السلطة الدينية الكنسية لتصوير الدين الإسلامي على أنه "التهديد " أو " الخطر" الذي يهدد الجماعة بوجودها ووحدتها، لذا شنّت بوصفها أقوى مؤسسة معرفية حملة معرفية تحضيرية منظّمة ضد الإسلام والمسلمين مصورة الإسلام على أنه دين "رجعي" و "قمعي" و "باطل" أوجده رجل " مشعوذ" و "دجال كبير"، أما المسلمون أنفسهم فهم متوحشون "كفار" و "مهرطقون" وهكذا نجحت الكنيسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر في تعميم معرفة هذا ثقافة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. وعلى الرغم من أن العديد من الرحالة والتجار الأوروبيين قد جذبهم الشرق بغناه وثروته، فتزايد عدد من تقدّم منهم بحثاً عن المغامرات أو الصفقات والمال، بل تزايدت أيضاً جنباً إلى جنب حملات التبشير والمبشرين، وسجلت العديد من الكتابات في هذا المجال، إلاّ أن هؤلاء التجار والرحالة ما جاؤوا إلى الشرق إلاّ ومعهم أفكارهم المسبقة وصورهم الجاهزة Pre-stereotypical images عن الشرق فلم يعطوا لأنفسهم الفرصة الكافية للتعرّف على هؤلاء "الآخرين" ولم يحاولوا فهم البيّنة السياسية والإجتماعية للمجتمع العربي، ولم يقيموا أي حزب من التفاعل المباشر بينهم وبين هؤلاء الآخرين من شأنه أن يعدل من حدّة هذه الإتجاهات المسبقة النمطية الجامدة. وهكذا فإن العديد من الصور النمطية عن الشرق كانت قد خلقت ذاتياً Self-created إلى حدّ كبير بهدف ملاءمتها للحاجات الإقتصادية والسياسية لهؤلاء الرحالة والتجار.[7] لقد تحول المسلم على يد هؤلاء إلى "غني" و "قرصان" و "تاجر رقيق" فضلاً عن كونه "مهرطق ومتوحش وهمجي" كما في الصور السابقة. كان هناك جمهور كبير يتلقف ما يكتب عن الشرق. والواقع أن الدراسات الإستشراقية إنطلقت من هذه البيئة ومن هذا الإطار، ونحن لهذا السبب يجب أن ندرك الإرتباط بينها وبين التبشير. فقد صادق مجمع فيينا (1312 م) الكنسي على أفكار روجر بيكون (1214- 1294م) وريمون لول ( 1225- 1216م) واللذين كانا يعتقدان بضرورة دراسة الحجج المضادة حتى يمكن دحضها، وأنه بالتالي حان الوقت لإخضاع المسلمين عن طريق التنصير كي تزول العقبة الكبيرة التي تقف في سيبل تحوّل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثوليكية. وقد صادق مجمّع فيينا على هذه الأفكار وأقرّ تعلّم اللغات الإسلامية والعربية تحديداً إلى خمس جامعات أوروبية (باريس- أكسفورد- بولونيا- سلمنكا- جامعة المدينة البابوية).
ومما هو جدير بالذكر أن قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج عام 1626 نصّ صراحة على خدمة هدفين أحدهما تجاري والآخر تبشيري كهنوتي بهدف توسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية "بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات" كما جاء في خطاب للمراجع الأكاديمية المسؤولة في جامعة كمبردج إلى مؤسس هذا الكرسي.
- الإستشراق والإستعمار:
شهدت هذه المرحلة من تطور المجتمع الغربي تغيّراً واضحاً في محتوى وشكل المعرفة المتعلّقة بالشرق، فما حدث في أوروبا من تغيير في البنى الإقتصادية والإجتماعية والسياسية مع الثورة الصناعية أدّى إلى توليد معرفة جديدة ذات مضمون إستعلائي وعدائي، عمد إلى تثبيت الصورة السلبية السابقة عن العرب والإسلام وأضاف نوعاً من الشرعية الأخلاقية عن الإدعاء بالتفوّق الحضاري والدور الملقى على الغرب بسبب تفوّقه الحضاري للأخذ بيد هؤلاء المتخلّفين، فظهرت مقولات "نحن" و"هم" و "غرب" و "شرق"، وهو ما عبرت عنه التقانة الإنكلوساكسونية عبر العبارة المشهورة عبء الرجل الأبيض (With man's burben) والتي تعبّر عن التمركز حول الذات والتي تفضي إلى أن تعتبر مجموعة بشرية ما، نفسها مرجعية لسائر المجموهات البشرية، وهذا يخفي شعوراً بالتفوق يتخّذ في غالبية الأحيان شكل الغطرسة وإزدراء الآخر، وبالتالي يصبح التاريخ "الذاتي" إطاراً لفهم العالم والحكم عليه، مما ينتج سلوكاً ينطلق من معيار أن ما يصلح للذات لا بد حتماً يصلح للآخر ولا بد من تعميمه.
عيوب نزعة "التمركز حول الذات" أو ما يسمّى في العلوم الإجتماعية الإثنية المركزية Ethnocentrism وهي النزعة التي تماهي بين الغرب والعالم وتعتبره عالم إمتداداً للغرب، بحيث تصبح السياسة الغربية تجاه الآخر مجرّد سياسة محلّية، تعبّر عنها أيضاً العبارة الإنكليزية الرائجة The west and the rest أي الغرب والباقي، وهذا ما تمّ ترجمته عملياً في سلوك إستعماري مارسه الغرب في مختلف قارات العالم إقترن بممارسات يندى لها جبين البشرية من النهب والقتل والتهجير.
عندما أرادت السلطة السياسية للدول الإستعمارية الكولونيالية التوسّع خارج حدودها الجغرافية بحثاً عن الأسواق والمستعمرات، إستعانت بالتراث الإستشراقي من أجل تسهيل عمليات التوسع، وقد قدم الإنتروبولوجيون خدمات جلّى في هذا المجال، ووضعوا خلاصة أبحاثهم ومعرفتهم المتعلّقة بكيفية التعامل مع هذا الآخر.
لقد استطاعت الإدارات الإستعمارية توظيف طاقات المستشرقين والإعتماد على جهودهم لخدمة أغراضها في ترسيخ سلطتها في المستعمرات، وأصبح العمل لدى هذه الإدارات وسيلة إرتزاقية لدى العديد من هؤلاء،حتى أنه من النادر أن نجد إسماً حتى من بين كبار المستشرقين بقي بعيداً عن لعبة تقديم الخدمات لحكومة بلاده في غدارة مستعمراتها.
لقد شكّلت معرفة المستشرق بالشرقي نوعاً من السلطة جعلته يدعي أنه خبيراً بخصائص وطبيعة الشرق وفئاته الإجتماعية فها هو Burton يدّعي بحكم خلفيته الإنتروبولوجية معرفة سمات شخصية البدوي وتركيبه النفسي والمزاجي حيث يقول :"إن بسالة البدوي نزقة وغير مؤكدة. والإنسان هو بالطبيعة حيوان مفترس، تكبحه علاقات المجتمع المعقّدة، ولكن سرعان ما ينحدر إلى عاداته القديمة. وخصال الضراوة والتعطّش للدماء تنمو سريعاً في الصحراء. إن الهمج وأشباه البرابرة هم دائماً حذرون ومحتاطون، أما المتحضّر فهو على نقيض ذلك. إن معاني الشجاعة عند العرب لا تخلب ألبابنا[8]". إن هذه المعرفة التي يمتلكها المستشرق عن الشرقي جعلته لا يقف عند هذا الحدّ من الإدعاء، بل أعطته سلطة خوّلته الذهاب إلى أبعد من ذلك، إلى حدّ الزعم بأنه "الوحيد" القادر على فهم نفسية و "عقلية" الآخر/الشرق، أكثر من معرفة الشرقي لها[9].
والواقع أن الإستشراق أصبح في حقيقة الأمر جزءاً من قضية الصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، وكان له الأثر الهام في صياغة التصورات الأوروبية عن الإسلام وفي تشكيل مواقفه منه ومن قضاياه على مدى قرون عديدة. بل إن الغرب لم يكتفِ بفهم دراسة الإسلام وحضارته كما يريد عبر الإستشراق، بل أراد أن يفرض هذا الفهم على المسلمين، وكأنه بإختصار يريد إعادة تشكيل عقلهم، وإعادة تركيب عقل آخر قام هو بإختراعه في رؤوسهم، يحمل ما يراه مناسباً، لأنهم لا يعرفون مصالحهم الحقيقية التي يعرفها الغربيون المستشرقون نيابة عنهم بطريقة أفضل. لذلك نصب المستشرقون من أنفسهم أوصياء بلسان الغرب على الشرق والشرقيين.
- الإستشراق والإنتروبولوجيا:
وجد الإنتربولوجيون مادتهم الأولى عند الشرق وعند الإسلام فيما كتبه المستشرقون والرحالة، فكانت تلك هي البدايات، لذلك يربط إدوارد سعيد بين الإستشراق والإنتروبولوجيا ليس في النشأة فقط، بل في المادة التي إعتمداها، ثم في أنهما علمان إستعماريان، أو أنهما نشآ في مرحلة الإستعمار ولخدمته. وهذا صحيح وإن كانت الإنتروبولوجيا كعلم وضعي متطور نشأ في القرن التاسع عشر، بدأ بجمع المعلومات ووضع الملاحظات في القرنين السابع عشر والثامن عشر عمل على تعميمها وتصنيفها، وهو فعلاً خضع لتوظيف إستعماري واسع طيلة تلك السنوات، إلاّ أنه حاول الإستقلال عنه فيما بعد بشكل واضح وهذا ما يوضحه جيرار لكلرك في كتابه القيم " الإنتروبولوجيا والإستعمار".[10]
أما الإستشراق فقد إرتبط منذ نشأته بعوامل وظروف مختلفة ومرّ بمراحل وتطورات جعلته يقترب من الإنتروبولوجيا مع فارق في المنهج. فالمنهج الإنتروبولوجي منهج تأصيلي يفسّر المشتركات بين البشر بالعودة إلى الأصل المفترض رمزاً أو حقيقة أو تاريخاً أو فسيولوجياً، بينما التاريخانية التي تعتمد الفيلولوجيا النصية، أو التطورات التاريخية، هي التي تسود في الإستشراق. كذلك فإن الأمر الأكثر تعقيداً متصل بعلاقة الإستشراق بالسلطة أو بالأحرى بالسلطات الإستعمارية. ففي حين كانت إشكالية الإنتروبولوجيا مزدوجة أو مركبة من إزدواجين، كان هناك إزدواج من نوع آخر في الإستشراق. في الإنتروبولوجيا كان هناك إزدواج البدائي في مواجهة المتحضّر، والمستعمر في مواجهة الستعمر. بينما كان الأبرز في الإستشراق بحسب إدوارد سعيد وطلال أسد ومدرسة نقد الإستعمار النقيض الثاني: مستعمِر/مستعمَر. فحتى بعد الإستقلال، كان الإستشراق يمارس في دوائر الجامعات التي أنتجت الأطروحات الأساسية عن المجتمعات غير الأوروبية، وغير الحديثة بالمقاييس نفسها. وإدوارد سعيد، بل وميمي وفرانز فانون وكلاستر وغوشيه (وغيرهم من محرري مجلة Libre) يرون هذه الثنائية مهمة وأساسية في فهم أطروحات الإستشراق الأساسية. وفي الواقع فقد كانت هناك محنة منهجية- إذا صحّ التعبير- ذلك أن الإصرار على تاريخانية الإستشراق أو إعتباره جزءاً من تخصص الشرق القديم والوسيط، أو جزءاً من تاريخ العالم، أوشك أن يلحقه لدى الماركسيين الدوغمائيين أو الرسميين بالمراحل الأربعة المعروفة، فلا يبقى ما يمكن فعله. وقد إستمر هذا التجاذب والجدال، أو بعبارة أخرى التساؤل عن الإستشراق، وهل هو علم أم لا، إلى أن ظهرت مدرسة الحوليات ومدرسة التاريخ العالمي، فصار ممكناً دراسة هذه المنطقة من العالم بطريقة سياقية لا تنافي ذاتيتُها عالميتها، ولا يؤدي إلى إعتبار المسلمين كائنات إنتروبولوجية ما خضعت للتطور التاريخي.[11]
حين كتب أنور عبد الملك دراسته الهامة "الإستشراق في أزمة" عام 1963 كشف أن الإستشراق يعاني بطرائقه الفيلولوجية والتاريخانية من مواريث عصر الإستعمار ومن جهة ثانية كشف أنه لم يستفد أيضاً من الثورة الحاصلة في العلوم الإجتماعية والتاريخية. والواقع أن هذه الملاحطة الأخيرة في منتهى الأهمية، إذ أن كل مدرسة نقد الإستشراق فيما بعد لم تنتبه إلى أن هذا التخصص أو المجال يتعرّض لإختراق تدريجي وتحوّل لتسميته، وإطلاق عناوين أخرى عليه مثل دراسات إسلامية أو شرق أوسطية أو تحوّله إلى إتنروبولوجيا. وقد برزت في هذا المجال دراسات إرنست غلز Ernest Geller وكليفورد غيرتز Clifford Geertz وزملاؤه من أمثال جيلسنان Gilsenanوأيكلمان Eickelman، في حين إستمرت مدرسة Libre وإستمر طلال أسد وجيرار لكلرك وفرد هاليداي وسامي زبيدة[12]، في النظر إلى الإنتروبولوجيا في إطار النقد الإستعماري، كما إستمروا جميعاً يقرون الظواهر في ضوء هذه المقولة. وإنفرد طلال أسد بنشر نقد جذري لأطروحة :إنتروبولوجيا الإسلام"[13].
يرى غلز أن الجوهر الأصلي للإسلام أنه دين نصي أخروي يتميّز بنزوع طهوري شديد، هذه الطهورية يخفف من حدتها التقليد الأكثري للسنة الذي يظهر في صورة توازن بين الأعراف المدينية والسلطة والعلماء. ولكن في الأزمات يعود النص إلى البروز ويظهر علماء
متشدّدون يتسلحون بالنص من أجل إستعادة الطهورية أو البراءة الأولى، وهي لن تستعاد طبعاً، ولكن في التقابل بين المدينة والقبيلة فازت المدينة، وبقيت الشرعية لدى العلماء، حراس النص ومؤوّليه والقائمين على ضياع الجماعة الشعائرية والعرفية في مواجهة السلطة المهزوزة لدولة القوة والضرورة. وقد تكون الأزمة الحالية تعبيراً عن تقبّل الحداثة. بهذه الصيغة المعقّدة، فالمناضلون الأصوليون هم في هذا السياق بحسب غلز أولئك الذين يعيدون قراءة النص لتجديد التقليد والدخول في العصر.
يختلف غيرتز مع غلز في رؤيته العامة للإسلام، فبحسب غيرتز لا يمكن أن يحدث تغيير ما في المجتمع أو الثقافة إذا ما أخذنا برؤية غلز حول الدورات المكرورة على النص الواحد والمجتمع الواحد مع بقاء الجوهر ثابتاً كما يزعم. بل الأحرى القول أن المجتمع الإسلامي مثل سائر المجتمعات شديد الحركة والتغيّر. أما البنى والثوابت البادية فهي رموز، تبقى عناوينها وتتغيّر معانيها، وتنقطع أو تتضاءل علاقاتها بالواقع في الأزمات فيظهر التشدّد بسبب توتر المقدّس. فليس هناك مجتمع عالمي إسلامي، بل هناك مجتمعات إسلامية وتقاليد إسلامية متعددة لا تجمعها إلاّ رموز ومقدسات عليا، تُظهر وحدة أو شبه وحدة في الوعي، لكن لا علاقة في الواقع بين ما يحدث في المغرب، وما يحدث في أندونيسيا. وتحدث التطورات الإجتماعية والثقافية في المجتمعات الإسلامية مثلما تحدث في المجتمعات الأخرى التي لا تدين بالإسلام.
غلز وغيرتز هما الشخصيتان اللتان سادتا ما عرف بإنتروبولوجيا الإسلام في العقود الثلاثة الأخيرة. ويرى سامي زبيدة أن المستشرقين الشبان إنحازوا في الغالب إلى رؤية غيرتز أو رؤية كلاستر ولكلرك وطلال أسد، إلاّ أن قلّة فضّلت رؤية غلز لأنها مباشرة ويمكن إستعمالها بطريقة أسهل في حكم سريع على الإسلام.[14]
وهذا ما يفسّر إختراق الإنتروبولوجيا للإستشراق والعلوم التاريخية، فهي تملك منظومة تفسيرية متكاملة يمكنها أن تفسّر كل شيء في الظاهرة الإجتماعية أو الدينية أو الثقافية.
- الإستشراق والسوسيولوجيا:
تسعى السوسيولوجيا إلى تحليل الدين بعيداً عن الفقه واللاهوت فتركز على الممارسة السلوكية في الواقع المعيشي وما تعتمد عليه المجموعات البشرية من معتقدات وتفسيرات للنصوص الدينية من منطلق مواقع البنية الإجتماعية. منطلق السوسيولوجيا وعلم الإجتماع يختلف منهجياً عن الإستشراق، فالأول يسعى إلى تحليل السلوك الديني في الحياة اليومية وما يستند إليه من تفسيرات خاصة للنصوص الدينية في السياق الإجتماعي والتاريخي، ومن منطلق التناقضات والصراعات القائمة داخل المجتمع وفي علاقاته بمجتمعات وحضارات أخرى، في حين يذهب الإستشراق بإتجاه تقديم تفسيرات خاصة للنصوص والوقائع والأحداث الدينية في الشرق بمعزل عن سياقها الإجتماعي والتاريخي، فعلياً الخلفية المعرفية الغربية التي ينطلق منها ودون أن يستعمل أدوات منهجية تحدّ من الإنحيازات المنهجية الفاضحة التي أصابت بعض دراساته.
والواقع أن السوسيولوجيا ترى الدين ظاهرة منبثقة من واقع إجتماعي وإقتصادي وسياسي وتاريخي شديد التعقيد يتطور بتطور هذا الواقع وهو يتصل بدور المؤسسات والبنى الإجتماعية (كالعائلة والطبقات والمؤسسة السياسية وغيرها) إتصالاً عضوياً وتفاعلياً، وهو يقوم بوظائف محددة ويلبي حاجات ظاهرة وخفية وقد تكون توظيفاته إيجابية أو سلبية، وكثيراً ما تكون التأويلات الدينية متنوعة بل متناقضة، وقد يتحوّل الدين من طاقة روحية ثورية في مراحل التكوين الأولى إلى مؤسسات ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية، ثم تحصل الإنقسامات والتناقضات ليس بسبب التنوع في المعتقدات بحد ذاتها، بل بسبب التناقضات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد يستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة في تثبيت شرعيتها وهيمنتها، أو من قبل القوى المعارضة للتحريض وإثارة السخط ضد النظام القائم، كذلك ليس بالإمكان إستعادة الماضي مهما كان ذلك مستحباً، وذلك لأن القيم والأفكار والمعتقدات تنبثق من واقع معين ولا يمكن فرضها من الخارج على واقع مخالف للواقع الذي نشأت فيه أصلاً من دون تطويرها والتخلي عن بعضها.[15] لهذه الأسباب كلها تنوعت القراءات والتحليلات عند علماء الإجتماع في الظاهرة الدينية، وهم لا يتفقون حول أصول الدين وطبيعة وظائفه في المجتمع ونوعية علاقته بالبنى الإجتماعية والإقتصادية والنظام السائد. يؤكد هيغل أن الأفكار والمعتقدات، أي البنية الفوقية هي التي تحدد السلوك الإنساني. وعلى العكس من ذلك تماماً يؤكد كارل ماركس على أن نمط الإنتاج والأوضاع الإقتصادية أو البنية التحتية هي التي تنشأ عنها الأفكار والمعتقدات. وبين هذين النقيضين يقف ماكس فيبر الذي يتراوح فكره بين التشديد على أولوية الأفكار والمعتقدات، كما في كتابه: الأخلاف البروتستانتية وروح الرأسمالية (وهو بذلك أقرب إلى هيغل) وعلى التفاعل بين الثقافة والبنى الإقتصادية، كما في كتاباته حول التنظيم الإجتماعي والإقتصادي، وعلى تغليب العوامل المادية في معالجته الجانبية للإسلام (وهو بهذا أقرب إلى ماركس).
لقد شدد عالم الإجتماع الألماني ماكس فيبر (1864-1920) في معالجته للإسلام، على عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق البوتستانتية ونشوء الرأسمالية في أوروبا، على الصلة الوثيقة بين الدين (خصوصاً الإسلامي) والسلوك اليومي الهادف ذي المضمون الإقتصادي، فقال في كتابه علم إجتماع الدين كلاماً يذكرنا بالتفسير الماركسي المادي: "إن غايات الدين...هي على الأغلب إقتصادية"[16]، وهو يرى أن دعوة النبي محمد r إكتسبت أهمية إجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في ضوء نمط معيشتهم ومصالحهم الإقتصادية. وبذلك إعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات الإسلامية، جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة. وبكلام أدق إعتبر الإسلام زواج بين القيم التجارية والقيم الفروسية البدوية والقيم الصوفية المعبرة عن عواطف الجماهير وحاجاتها، ونتيجة لهذه المزاوجة الثلاثية، وجهت الطبقة المحاربة الإسلام بإتجاه الجهاد والأخلاقية العسكرية، ووجهته الطبقة التجارية في المدن بإتجاه التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية، ووجهته الجماهير المستضعفة بالإتجاه الصوفي والهرب الضبابي[17]. وقد ساهمت هذه القيم التقليدية بإستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة، وهو ما أسماه فيبر الولاء والطاعة للسلطان-الحاكم Patrimonialism الذي يحصر القرارت بشخصه مدعياً أنه ظلّ الله على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين المدنية. أي أن فيبر رأى تعارضاً بين الإسلام وروح الرأسمالية ونشوء المؤسسات بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين.
لم يقلل براين ترنر في نقده لآراء فيبر من أهمية العوامل الإجتماعية والإقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره، بل ركز على جوانب معينة، منها الفراغ السياسي الذي حلّ في المنطقة حينها نتيجة الصراع البيزنطي- الفارسي الذي أضعفهما معاً فأدّى لبروز الإسلام وإنتشاره، وبروز مكة ثانياً كمركز تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية، الأمر الذي أدّى إلى تطورات بنيوية في الجزيرة العربية كان من بينها إنحلال القيم التقليدية وبدء إنتشار قيم الكسب والجاه والرفاهية الفردية. في هذه المرحلة الإنتقالية نشأت حالة البحث عن الخلاص والإستعداد النفسي لتقبّل قيم بديلة، وهذا ما قدّمه الإسلام، فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت تعيشه الجزيرة العربية آنذاك.
من بين الباحثين الرواد في حقل علم إجتماع الدين جورج سيمل George simmel (1858-1918) إعتبر أن الكثير من المشاعر والتعبيرات التي تنسب للدين هي عناصر جوهرية من عناصر التفاعل الإجتماعي عامة، فالتأليه والإلتزام والعبادة والمحبة أمور مشتركة في كل أشكال التجارب والعلاقات الإنسانية في مختلف العصور والمجتمعات قبل ظهور الأديان وبعدها، من هنا يرى أهمية دراسة دور المجتمع في نشوء الدين وتطوره. وهذا ما ذهب إليه عالم الإجتماع الفرنسي إميل دوركايم (1858-1917) الذي إعتبر أن "روح الدين" هو في الواقع "فكرة المجتمع" نفسه، وهو رمز المجتمع والمعبّر عن وحدته وعصبيته. إن إله العشيرة نفسها مشخصنة أو ممثلة بالإله بحسب التصور الإنساني، وبذلك تكون وظيفة الدين الأساسية هي تعزيز وحدة المجتمع وإعطاء الشرعية لقيمه ومعاييره وإضفاء القداسة عليها وبتجميع الناس معاً في هدية موحدة من خلال ممارسة الشعائر والطقوس الدينية. وبحسب دوركايم إن ما نسميه الأديان "الله" هو في الواقع المجتمع نفسه، ويستدل على ذلك من مفاهيم الطوطم ومبادئ الطوطمية التي لها شأن كبير في التنظيم والتماسك الإجتماعيين. والطوطم هو جسم ورمز للأب أو الجدّ الذي يتحدّر منه أفراد القبيلة فينظرون إليه بإحترام وخشوع. وهذا الطوطم ليس مهماً بحدّ ذاته، بل بما يمثّل أنه رمز لروح القبيلة وإستمرارها، والمعبّر عن شخصيتها وهويتها، بل إن المجتمع يتجسّد في الطوطم والألهة فيكون هو موضع العبادة، وذلك لحاجة المجتمع أن يؤكد ذاته بذاته ويرسخ شرعيته وقيمه. وبحسب هذه الرؤية يكون الله صورة المجتمع وليس المجتمع صورة الله.[18]
أكّد دوركايم على الوظيفة الإيجابية للدين وهي التماسك الإجتماعي، لكن كارل ماركس ركّز على سوء إستعمال الدين من قبل المؤسسات والطبقات المهيمنة من حيث الدعوة لترسيخ قيم الصبر والمصالحة مع الواقع المرير، فإعتبره من هذه الناحية "أفيون الشعوب" لأنه يشجع الضعفاء على تقبّل أوضاعهم والإستكانة لها بدلاً من العمل على تغييرها.
أما علماء الإجتماع المعاصرين فقد تابع قسم منهم تحليل الظاهرة الدينية على مستوى الماكروسوسيولوجي Macrosociology فقدم بيار بورديو قراءته على ضوء مفهوم الحقل الديني الذي هو كباقي الحقول (الإقتصادية والسياسية والفنية...) على الرغم من إستقلاله النسبي، إلاّ أنه لا يمكن إدراك بنيته إلاّ من خلال التفكير فيه علائقياً. فالحقل هو جملة متشابكة، هي عبارة عن مواقع وسلطات أو مواقف وخيارات أو مصالح وإستراتيجيات أو رهانات وإستثمارات، هذه العناصر تدخل في تركيب الحقل على نحو يجعل منه "بنية تفاضلية" تعمل بحسب مبدأ أساسي يقوم على " توزيع أنماط السلطة وأنواع رأس المال". ورؤوس الأموال على نوعين كبيرين: رمزية كالمعتقدات والمنتوجات الثقافية والعلمية، ومادية كالأموال والموارد الطبيعية والسلع الإستهلاكية والمنتجات التقنية. والسلطات كذلك على نوعين "مادية" تتمثّل في مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش والقضاء و"رمزية" تتمثّل في السلطات الثقافية من دينية وخلقية وأدبية. الأولى تمارس العنف الفيزيائي والثانية تمارس العنف الرمزي بأجهزتها الإيديولوجية، الأمر الذي يجعلنا أمام نوعين من الشرطة: شرطة أمنية تقوم بحراسة الأجساد والممتلكات، وشرطة فكرية تقوم بحراسة القيم والمعتقدات[19].
والواقع بيار بورديو يعتبر من أواخر علماء الإجتماع الذين قدموا ما يمكن أن نطلق عليه مقاربة ماكروسوسيولوجية ممثلاً للإتجاه الشمولي في الدراسات الإجتماعية Holistic approach، فقد حصل تحوّل بعده في الدراسات الغربية، ساد فيه من المقاربات الميكروسوسيولوجية Microsociology والإتجاه الذري التجزيئي Atomic Approach، وهو ما يشكّل مأزقاً خطيراً للدراسات السوسيولوجية لأنه يؤدي إلى طغيان النزعة التجريدية الكمية في العلوم الإنسانية ويجعل الظاهرة الإجتماعية تفلت من التحليل الشمولي الذي يربطها بالبناء الإجتماعي ككل. وبالتالي شكلت معالجة الظاهرة الدينية لدى الغربيين إنطلاقاً من هذه المقاربة مأزقاً مستعصياً جعلهم غير قادرين على تقديم تفسيرات عميقة لما يجري في العالم الإسلامي في تعميق تخلّف الدراسات الإسلامية في الغرب.
- ميلاد الإسلامولوجيا الجديدة:
مع ذلك لا يمكن أن نعمم بشكل مطلق هذه الملاحظة، ولكن هناك تيار جديد نشأ بلا شكّ وهذا ما يوضحه أوليفيه روا، وهو أحد أبرز الباحثين الفرنسيين في مجال الإسلامولوجيا، وهو من أقطاب "الإستشراق الفرنسي الجديد". فيقول : "إنتقلت الدراسات الإسلامية عندنا من فترة المستشرقين الكلاسيكيين الذين كان إهتمامهم منصبّاً أساساً في التخصص في مجالات دراسة القرآن والتاريخ الإسلامي واللغات والآداب الشرقية، أمثال مكسيم رودنسون وجاك بيرك وكلود كاهين، إلى جيل جديد من الباحثين المتخصصين أساساً في السوسيولوجيا والعلوم السياسية. هذه الفئة الجديدة من الباحثين لا ترى أن الدراسات الفقهية القرآنية أو التاريخية هي أداتها الرئيسية في دراسة الظواهر الإسلامية المعاصرة وتحليلها، بل المحكّ بالنسبة لها هو البحوث الميدانية. المستشرقون الكلاسيكيون كانوا يرون أن تعلّم ودراسة القرآن والتخصص في مجال التاريخ الإسلامي هو المفتاح العلمي الذي يؤهلهم لفهم الظواهر الإسلامية وتحليلها، بما في ذلك المعاصرة منها. أما جيلنا الحالي، فقد تجاوز هذه النظرة الضيّقة وأصبحت دراسة القرآن والتاريخ واللغات والآداب الشرقية بالنسبة لنا لا تعدوا أن تكون أدوات بحث نستعين بها خلال تنقلاتنا وأسفارنا ودراستنا الميدانية. ونحن بخلاف الكلاسيكيين لا نسعى لفهم الظواهر الإسلامية المعاصرة في ضوء دراسة التاريخ أو الفقه أو الآداب القديمة، بل تنعامل مع هذه الظواهر التي ندرسها من خلال أدوات البحث العلمي التي نعتمدها لتحليل أي ظواهر إجتماعية أو سياسية أخرى ندرسها شرقية كانت أم غربية. لكن هذا لا يعني أن هذا الجيل من الباحثين له نظرة واحدة وآراء متوافقة في مجال الإسلاميات والإستشراق، بل لكل واحد منهم خصوصيته وتوجهه وأفكاره، أما السمة المشتركة التي جعلتهم يؤلفون ظاهرة متميزة فتكمن في كونهم جميعاً متخصصين إما في السوسيولوجيا أو في العلوم السياسية، وهو ما يجعلهم يغلبون دوماً الدراسة الميدانية على دراسة النصوص[20]. لا شكّ أن هذا الجيل من الباحثين في الإسلامولوجيا لم ينطلق من الفراغ، فهم ليسوا أول من إعتمد المقاربة السوسيولوجية الميدانية في مجال الإستشراق، فالمستشرق الفرنسي الكلاسيكي مكسيم رودنسون ولأنه كان يحمل أفكاراً يسارية كان له إهتمام خاص بالحركات والظواهر الإجتماعية، كذلك كانت اللبنات الأولى مع الرواد خلال الحملات الإستعمارية الذين خولتهم مهامهم إجراء أبحاث سوسيولوجية وإنتروبولوجية لإستيعاب خصوصية الثقافات المحلية للمجتمعات الإسلامية التي عايشوها، وهو ما جعلهم لاحقاً مناصرين لقضايا التحرر الوطني لشعوب المستعمرات الفرنسية السابقة كجاك بيرك وريمي مونتاني كنماذج بارزة في طليعة منظري وصناع ما يعرف بـ " السياسة العربية" لفرنسا لاحقاً.
يرى اوليفيه روا أن التحول الذي حققه الجيل الجديد من المستشرقين يعود لعدّة أسباب أهمها خصوصية الإستشراق الفرنسي المغاير للتجربة الإنغلوساكسونية والتي يمثّلها اليوم برنارد لويس، والقطيعة التي تعمّقت أكثر، بفضل ما إكتسبناه نحن الأكاديميين من استقلالية فكرية وتحويلية، ومن هامش نقدي تجاه المؤسسات الرسمية ومراكز القرار السياسي والعسكري. ينتقد أوليفيه روا أعمال برنارد لويس بشدّة لأنه لا يزال يعتمد الأدوات الكلاسيكية الأمر الذي أدّى به إلى الإرتماء بأحضان المحافظين الجدد وإتخاذه مواقف عدائية من الإسلام والمسلمين، كما ينتقد بنفس الوقت أعمال بعض الأميركيين من نفس الإتجاه المناصرين للإسلام أمثال جون اسبوزيتو، معتبراً أن الخلل البحثي في كلتا الحالتين يكمن في أن الظواهر الإسلامية الراهنة لا يمكن تفسيرها أو فهمها في ضوء النصوص الفقهية وحدها، أو بإسترجاع التراث التاريخي الإسلامي وتحليله فقط، بل يجب قبّل كل شيء وضع كل تجربة إسلامية في سياق الظرف الإجتماعي والسياسي المعاصر الذي يحيط بها. فهذه هي المقاربة الوحيدة كما يقول، التي تجعلنا نفهم كيف يمكن أن يكون شخصاً أو تياراً إسلامياً معتدلاً، فيما أشخاص أو تيارات أخرى متطرفة أو أكثر راديكالية، مع أنهم جميعاً ينطلقون من نص قرآني واحد ومن مرجعية فقهية مشتركة.
أوليفيه روا قدم مجموعة من الأبحاث الهامة كنماذج عن هذا الإتجاه الجديد منها مثل الإسلام السياسي (1992)، جينالوجيا الحركات الإسلامية (1995)، آسيا الوسطى الجديدة أو مصنع الأمم (1997)، إيران: كيف يمكن الخروج من ثورة دينية (1999) نحو إسلام أوروبي(1999)، الشبكات الإسلامية (2002)، تركيا اليوم هل هي بلد أوروبي (2004)، عولمة الإسلام (2002).
في كتابه عولمة الإسلام يرصد بدقّة تحولات الظاهرة الإسلامية فيما يتعلّق بالعولمة ويقدّم أمثلة دالة على الإنخراط في ديناميات العولمة حيث بدأت الحركات الإسلامية تتجاوز مشكلة الثقافة وتتفاعل مع الثقافات الفرعية، تساعدها على ذلك ثورة الإتصالات، إقتصاد السوق، أنماط جديدة للمجتمع، تراجع الدولة الوطنية. فيلاحظ أن الإسلاميين استفادوا كثيراً من ثورة المعلومات وهم الأكثر توظيفاً لمعطياتها، ويرصد ظاهرة الدعاة خارج المؤسسة الدينية، والتعليم العصامي، وتوظيفهم للتقنيات الحديثة مما يؤدي إلى ضرب النظرية التقليدية الإسلامية في تحصيل المعرفة. ثم يرصد ظاهرة الإنفتاح على السوق فلا يجد ممانعة لدى الإسلاميين للخصخصة وإعادة الهيكلة وانسحاب الدولة من الإقتصاد، وتحت عنوان مصالحة الدين والثروة يلاحظ كيف كانوا في السبعينات يأتون إلى الإسلام من أحزمة الفقر وكانت فكرة العدالة الإجتماعية في الأولويات في حين لم تعد هذه القضية من نفس المستوى، ويتابع راصداً دخول الدعوة الإسلامية نفسها منطق السوق، فيتحدّث عن إقتصاديات نشأت حول الظاهرة بدءاً الكاسيت إلى محلات الحجاب إلى البنوك الإسلامية وأشكال الإستثمارات. كما يرصد حالة دينية متزايدة في الطبقات العليا والبورجوازية. وبعد أن كانوا ضدّ حقوق الإنسان صار هناك الآن (حركة سواسية-إخوان) فتمّ إنشاء مراكز يتم التفاعل معها في مساحة مناهضة للعولمة-مما يعني أن تفهم الإسلاميين لدور المنظمات العالمية يحصل دون مشكلة وبشكل تدريجي.
في الواقع نجد داخل هذا الإتجاه الجديد توجهات وتيارات معقّدة منهم فرانسوا بورغا وهو باحث نشيط وذو إتجاه يساري مناصر لقضايا العالم الثالث، كذلك ميشال سورا الذي غيّبه الموت مبكراً في بيروت وكان باحثاً واعداً، وأيضاً جيل كيبيل الذي سنعرض لبعض أعماله.
وتعتبر الدراسة التي قدّمهابرنار روجيه (1993) نموذجاً لهذه الدراسات (الإخوان والجامع في الجزائر، إستطلاع للحركة الإسلامية في الجزائر) وهي دراسة ميدانية في مدينة قسنطينة وبعض المدن الجزائرية، يرى فيها أن الجوامع كانت محور العمل والحجرات الحقيقية لفهم معظم التناقضات الإجتماعية، وينطلق رواجيه من تساؤل حول معنى تكاثر الجوامع والمساجد بالنسبة إلى مجتمع لا يزال يعاني من آثار حرب مدمرة، وكيف ينظر لها محركيها الروحيين وداعميها، وما هي أدوارها الدينية والإجتماعية التي بنيت لأجلها؟ وقد إنطلق في دراسته من تجاوز المظاهر والخفايا حول الدين إلى الممارسات العقلية التي كان الفاعلون الإجتماعيون يمارسونها وخصوصاً في إطار إنماء المساجد والجوامع[21].
أما جيل كيبيل فهو من أبرز الوجوه في هذا المجال أيضاً وصاحب إنتاج غزير، وقد صدرت له مجموعة دراسات منها النبي والفرعون (1984)، وضواحي الإسلام (1987)، ويوم الله (1992)، غربي الله (1995)، والجهاد (2000)[22].
وكتابه هذا يعتبر من أنضج كتبه والأطروحة المركزية التي يحتويها يتكأ في تأويلها على مفاهيم سوسيولوجية نجد معالم بعضها عند ماركس فيبر (فيما يتعلق بالدين والمدينة ودور المؤسسة الدينية) وعند بيار بورديو (فيما يخصّ "الحقلين" الديني والسياسي)، والأطروحة هذه هي التي تشرح مكونات التيار الإسلامي وتبحث في الفئات الإجتماعية والثقافية التي حملت لواءه. فترى أن هذا التيار تكون من ثلاث قوى هي الشباب المديني الفقير، والطبقة الوسطى المتدينة، والإنتلجسيا الإسلامية. القوة الأولى أي الشباب المديني الفقير تشكّلت بعد الإنفجار السكاني وهجرة الأرياف إلى المدن في الخمسينات والستينات وأنشأت الضواحي وسكنتها. وما يميّز هذه الفئة هو حصولها وللمرة الأولى في تاريخ الطبقة التي تنتمي إليها على التعليم نتيجة سياسات الحكومات المتبعة يومذاك والتي تعزّز القطاع العام وأنشطته التعليمية. غير أن هذه القوى الشابة المتعلّمة نسبياً لم تجد إلى سوق العمل وإلى الإرتقاء الإقتصادي والإجتماعي سبيلاً، فأضيف إلى قهر ظروفها الطبيعية شعور بالغبن والحرمان وحنق على النظام حرماها العدالة الإجتماعية. ولما كان أبناؤها جميعاً جميعهم من مواليد العقد الذي تلا الإستقلالات الوطنية، ومن الذين شهدوا هزيمة الأنظمة القائمة أمام إسرائيل، سقطت مشروعية هذه الأنظمة في نظرهم لفشلها على مختلف المستويات الداخلية والخارجية.
وبدءاً من العام 1970 تاريخ رحيل جمال عبد الناصر وتراجع المشروع القومي العربي راح هؤلاء الشباب يبحثون عن "فكر بديل" فإكتشفوا الفكر الإسلامي بنصوصه المنتجة في الستينات، وخصوصاً أفكار سيد قطب في إستعادته لأفكار حسن البنا وأبو الأعلى المودودي، ثم كانت أفكار الخميني وشريقي في إيران. وقد رافق التحول في القراءة والإستلهام العقائدي تبدل عميق في التركيبة الديموغرافية، بحيث يصبح سكان المدن المتوسعة الأكثرية للمرة الأولى في تاريخ العالم الإسلامي. وانعكس هذا التبدل على نحو حاسم في علاقة الناس بالدين ونصه، إذ باتوا مستقلين في علاقتهم به عن "المعممين"، الذين هم الوسطاء الوحيدون في الأرياف والمدن الصغرى، ومستقلين عن القرار السياسي للمؤسسة الدينية المرتبطة غالباً بالسلطة، ويمكن القول أن تطبيق الشريعة الإسلامية كان يعني بالنسبة إلى هذه الفئة الفقيرة إحلال العدالة الإجتماعية الحقيقية وقلب الأنظمة التي تعوّق ذلك.
القوة الثانية المكونة للتيار الإسلامي أي الطبقة الوسطى المتدينة، عانت بدورها من الأنظمة القائمة، وإن كانت "معاناتها" مختلفة. فأبناؤها من التجار (البازاريون) وملاك الأراضي الذين نزعت منهم ملكيتهم عقب سياسات التأميم، وهم في أكثريتهم من المهمشين سياسياً، إذ أقصاهم العسكر أو الملوك عن السلطة ومرافقها. وإنضم إليهم في السبعينات بعض "المهنيين" الذين راكموا ثروات في الخليج العربي إثر الطفرة النفطية واكتشفوا الوهابية واعتنقوها، وراحوا بعد عودتهم يستثمرون في البنوك الإسلامية، ويقيمون الأنشطة والمشاريع الخيرية. ويجمع هؤلاء شعور بأن لا فضب لـ "دولهم" عليهم وعلى إرتقائهم الإجتماعي، ولا نية لديها لتقريبهم من مراكز القرار فيها. وهم يرون ضرورة التحالف مع القوة الأولى (الشباب المدينيون الفقراء) من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، لا طمعاً بالعدالة الإجتماعية بل بهدف قلب الأنظمة والإمساك بالسلطة. أما القوة الثالثة، أي الإنتلجسيا الإسلامية، فمكونة من مثقفين إسلاميين شكلوا "الخميرة" التي تضاف إلى القوتين الأولى والثانية لتقربهما الواحدة من الأخرى، وتطلق خطاباً يكون محور التحالف بينهما، وهو خطاب يجانب القضايا الإجتماعية ويركز على السياسة والأخلاف هرباً من إتخاذ موقف "طبقي" ينفّر إحدى القوتين الأوليين منه. بتحالف هذه المكونات الثلاث وتكاملها نهض التيار الإسلامي ونمت الحالة الإسلامية في السبعينات والثمانينات كما يرى جيل كيبيل، ثم انفكّ عقدها وبدأ التراجع في التسعينات. وتراجع الظاهرة الإسلامية عنده لا يعني نهايتها، بل يعني فقدانها ديناميتها الأساسية، أي قدرتها على جمع الطبقات الإجتماعية المختلفة ودفعها إلى حمل مشروع سياسي مشترك. كما أن الصراعات التي تفجرّت في التسعينات ساهمت في تنامي الإنقسام والتفتيت داخل الحركة الإسلامية الأمر الذي ساهم في تأكيد الإنحسار الذي يتحدّث عنه كيبيل.
يقدم الباحث السويسري باتريك هايني نموذجاً شيّقاً من هذه الكتابات، فيرصد في كتابه "إسلام السوق"[23] جانباً مغيّباً من الظاهرة الإسلامية المعاصرة غفل عنه الدارسون، في الوقت الذي تتنافس فيه وسائل الإعلام ومراكز البحث في الكتابة على ما يسمى الإسلام السياسي. وإنطلاقاً من مصر ومروراً بإندونيسيا وانتهاءً بتركيا، يحلل "إسلام السوق" بزوغ شكل جديد من أشكال الكينونة الإسلامية تخرج من صلب إسلام سياسي ظهر عليه التعب، أو تمر محاذية له، تشترك معه في المنبع لكنها تختلف معه في الهدف والوسيلة وتحديد مجالات العمل.
في بداية كتابه يشخّص هايني إزدياد الإسلاميين الغاضبين الذين ينتقدون في الآن نفسه الإيديولوجيات الإسلامية ليقينيتها، وبنيانها التنظيمية بجمودها وقسوتها، ولكن دون أن يصل هذا الموقف بأصحابه إلى مغادرة الحقل الإسلامي، بل يدفعهم هذا إلى البحث عن طريق للخلاص الفردي وتحقيق الذات والنجاخ الإقتصادي. ويثير المؤلف الإنتباه إلى التنافس بين الدعاة الجدد في إستثمار موجه الصحوة الإسلامية المنفلتة من قبضة التنظيمات الإسلامية والمستعصية عليها، وسعي هؤلاء الدعاة إلى إنجاز مصالحة توفيقية بين المدّ الديني والحداثة الغربية، ويحدث هذا من خلال عدّة مسائل وتعادلات دعوية تستخدم الطرق الأميركية في الدعاية، وتشجع ميلاد فرق موسيقية عصرية ووجوه دعوية نسائية حديثة ويستعرض أربع سيناريوهات:
- تجازو الإسلام السياسي حدث عندما تجمّد التدين النضالي وشعر المنخرطون فيه بالجمود التنظيمي، فوجدوا الحل بالإنفتاح على العصر و"أسلمة" منتجاته، وهكذا يتحول الجهاد عن مكانه ليصير جهاداً إلكترونياً، ويتابع قصّة ظهور النشيد الإسلامي من بداياته الملتزمة وتعبيره عن قضايا الأمة إلى ظهور الفرق الغنائية الحديثة التي صارت تمتهن الدعوة بالموسيقى، وفي المسار نفسه يرصد كيف إنخرطت الحشمة الإسلامية وزيّها الخارجي لتنتقل من الحجاب المناضل ذي الرمزية السياسية إلى الإستهلاك الجماعي والتأثر بالموضة. ويقدم المؤلف تركيا نموذجاً إسلامياً للإندماج في إقتصاد السوق وبروز برجوازية إسلامية تصنع فضاءً إعلامياً جديداً تلتقي فيه العولمة بالإحيائية الدينية الإسلامية، وتغيّر الحشمة من وجهها وملامحها وألوانها وأشكالها، ثم يتوج كل ذلك بالموجة الثالثة من الحجاب في الإسلام الأوروبي. ثم تظهر القنوات الفضائية متأثرة بالتجربة الإعلامية الإنجيلية الأميركية، لدى نجمين من نجوم الوعظ التلفزيوني وهما المصري عمرو خالد والأندونيسي عبد الله جمنستيار، فالأول إكتسب الطريقة من متابعة الوعاظ الأميركيين في قنواتهم، والثاني دربه عليها واعظ أميركي إنجيلي سابق إستطاع مضاعفة أعضاء كنيسته في عامين فقط بفضل تقنيات التسويق الإعلامي، قبل أن يعتنق الإسلام عام 1997 ويصير مستشاراً لجمنستيار.
- قانون السوق يفرض نفسه في علاقة الإسلاميين الجدد برجال الأعمال والإقتصاد، فقد وجد هؤلاء أن السوق هو القناة الوحيدة للتعبير. وأن السوق لم تعد وظيفته الترويج للأفكار وإقناع الرواد بها فقط، ولكن صارت أيضاً تلبية طلبات الجمهور المستهدف واغلبه من البرجوازية المتدنية الكارهة لكل نضال ذي محتوى سياسي بالمعنى الأصيل أو بالمعنى الدخيل. ويضرب المؤلف المثال بتجارة الأشرطة الدينية في القاهرة والتي تظهر أن مقاولات الإنتاج والترويج تستطيع تجاوز البنيات السلطية الموجودة وتسعى إلى الإقناع عن طريق الإغراء، بل إن الوعاظ الجدد لا يجدون مانعاً من الظهور في قنوات تجارية محضة أو غير إسلامية، وهي بدورها تشتري حقّ البثّ لأغراض تجارية بحتة. قانون السوق يستطيع إلحاق الهزيمة بالسلفيين أيضاً فيلجون عالم التسويق " التسويق الأخلاقي" –حسب تعبيرهم- والسوق الحلال خاصة في تجارة الملابس. وما أن يستغني رواد هذا السوق حتى يفكروا في الهجرة من ضواحي المدن الغربية المهددة بخلايا القاعدة، لا للعيش في البلدان الأصلية، بل للإستقرار في بلدان الخليج حيث يوجد الطلب على السلع العروضة.
- عقيدة الرفاهية يفرد لها فصلاً يرصد فيه جهد رواد إسلام السوق للمجتمع بين التقوى والغنى. فيبيّن كيف أن عبد الله جمنستيار يصرّ على أن رسول الإسلام (صلعم) كان رجل أعمال ناجح، ويكتب عمرو خالد أن الثروة والغنى وسيلة لإتقان التديّن وتقديم نموذج جيّد، ويدافع الإسلاميون الأتراك المقربون من حزب العدالة والتنمية عن أن القرآن الكريم يدعو إلى تكديس الثروة وأن الفقر يؤدي إلى الكفر. وفي السياق نفسه يؤسس الوعاظ المرشدون الجدد لعقيدتي الرفاهية والتنمية الفردانية متأثرين بالكاتب الأميركي ستيفن كوفي صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية والعالم (العادات السبع للناس الأكثر فعالية).
- يرصد هايني توجه الحركة الدينية الليبرالية الجديدة التي إستطاعت أن تشطب مطلب الدولة الإسلامية من قائمة الأهداف كما روجت لذلك الحركة الإسلامية طويلاً، فيرى أنها إستطاعت أن تعيد الإعتبار إلى المجتمع المدني ضد مفهوم الدولة الراعية المهيمنة على كل شيء واستطاعت إنشاء عدّة مشاريع ناجحة في العالم العربي والإسلامي، وصار الهدف لديها إنشاء "مجتمعات مدينة فاضلة" تشبه في طريقة عملها المؤسسات الدينية الأميركية الموازية للحزب الجمهوري الأمي

abdelaali sghiri- سوسيولوجي جديد

-
 عدد المساهمات : 37
عدد المساهمات : 37
تاريخ الميلاد : 10/10/1990
تاريخ التسجيل : 03/09/2011
العمر : 34
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى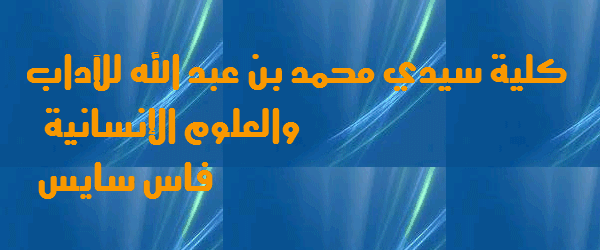

» سيغموند فرويد الشخصية السوية والشخصية الغير سوية
» بحث حول دراسات المؤسسة في علم الاجتماع
» مكتبة علم الإجتماع الإلكترونية
» سوسيولوجيا العالم العربي.. مواقف وفرضيات
» نظرية بياجي في النمو أو نظرية النمو المعرفي
» معجم و مصطلحات علم الاجتماع
» النظريات السوسيولوجية
» مفهوم المدينة عند ماكس فيبر